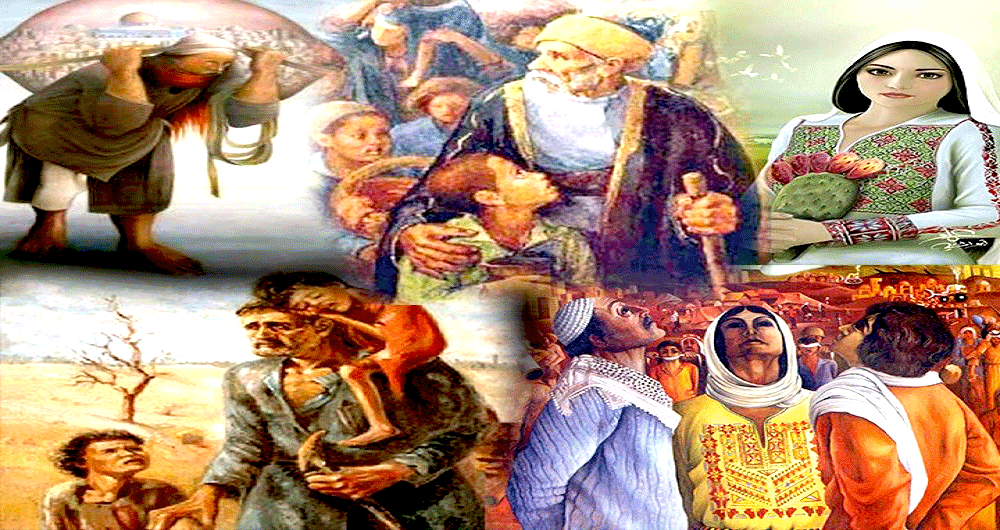من روائع الأديب الكاتب

المهندس/ محمود صقر.
25/04/2021
كان ظهور التليفزيون هو بداية عصر الانتقال من الفضاء المفتوح الذي كنا نتواصل فيه كبشر وجها لوجه، إلى الانغلاق داخل الغرف والتواصل عبر وسائط إليكترونية، وكان انتقالاً من عالم الخيال الخصب، إلى عالم الانحصار داخل إطار الصورة.
حديثنا عن فترة السبعينيات والثمانينيات، وموقع الأحداث هو بيت الأميرة شهرزاد رقم 33 شارع باب الكراستة بحي اللبان.
بدأ التليفزيون خجولا في الستينيات ثم ازداد انتشارا في النصف الثاني من السبعينيات، وظل يقتصر على قنوات محلية محدودة وساعات بث محدودة في الثمانينيات، ثم تنامى تأثيره بدءا من التسعينيات مع ظهور القنوات الفضائية.
كانت مساحة الوقت التي يشغلها التليفزيون من حياة جيل السبعينيات والثمانينيات محدودة نسبيا، وكانت ما تزال هناك مساحة من الوقت لممارسة أنشطتنا الاعتيادية؛ كنا ما زلنا نلعب الكرة في حوش البيت أو في الشوارع والساحات، ونصنع الكرة الشراب بأنفسنا من قطع الإسفنج والقماش والخيوط، ونصنع الطائرات الورقية بأيدينا أو نشتريها من محل “سي أحمد” في الوسعاية قريبا من ساحة بكير، ونطيرها من أسطح المنازل ونتبارى مع أصدقائنا من أسطح العمارات المجاورة، ومع طلوعنا للسطح كنا نشاهد وقت الغروب الحمام العائد إلى عششه فوق أسطح المنازل، وأصحابها من هواة تربية الحمام يلوحون لها بالأعلام، ونمسح بأيدينا على ظهر السلحفاة العجوز التي كانت تقتنيها وترعاها جارتنا أم سعيد في غرفة بالسطح.

كانت الشوارع الفرعية والساحات تتحول بعد العصر لكرنفالات للعب ومشاهدة كرة القدم (الكرة الشراب)، وينظم أبناء الحي دورات للفوز بكأس يساهم في ثمنه اشتراكات الفرق وتبرعات تجار الحي، وكان للكرة الشراب نجوم ينافسون بشهرتهم نجوم الفرق الكبرى، فشهرة “سعيد أَيَّر” لاعب الكرة الشراب من بحرى و “دُبَل” و “رومة” من اللبان، كانت تتساوى مع شهرة “شِحتة الاسكندراني” و “بوبو”، وكنا نتبارى نحن فريق أبناء بيت الأميرة شهرزاد مع فرق الحارات المجاورة، ولم نفز فيها بالكأس ولا مرة واحدة، ولما كثر القيل والقال من سيدات البيت عن خيبة فريقنا، قرر “علاء” قائد فريقنا أن يأخذ كأسا فضيا من دولاب الفضيات لوالدته “أم مشمش”، وقادنا لمشهد تمثيلي رفعناه فيه على الأعناق ودخلنا به للحوش رافعا كأس والدته “أم مشمش” على أنه كأس الفوز.!

ولم يكتف علاء باستغلال كأس والدته، بل كان يقوم في الصيف بنصب شبكة في منتصف طاولة الطعام في غرفة السفرة ونلعب كرة الطاولة (بنج بونج).
وبين الصالة وغرف النوم كنا ننصب حبالا على مفصلات الباب الخشبي العملاق ذي الضلفتين ونحولها لمراجيح.
كنا نجلس طويلا على رخام بسطة السلم الأبيض صبيانا وبنات في جلسات سمر طويلة، وكان “مجدي” شقيق روحي وصديق طفولتي مغرماً بحكاية الأفلام القديمة، وكان خياله يتسع لإضافة مشاهد لم تكن موجودة بالفيلم الذي يحكيه، وكان أشد ما يزعجه أن يكون أحدنا قد شاهدَ الفيلم الذي يحكيه ويعارضه بإنكار المشاهد التي يضيفها من خياله، وكانت أسعد انطلاقاته وإبداعاته حين يسألنا: “حد فيكم دخل فيلم كذا”؟،
فإذا قلنا جميعاً : “لا”، ينشرح صدره وتنفرج أساريره ويقول: “إذاً؛ آخد راحتي”، وأحياناً يتحرر من كل القيود ويقول لنا: “سأحكي لكم فيلم [ نَتٓشْ ]”!، يعني إيه فيلم “نَتٓشْ”.؟ يعني فيلم من ألفه ليائه من خياله هو.
أمتع تلك الأفلام بالنسبة لنا كان فيلم “النتش” نسرح فيه مع “مجدي” بخيالنا، ونحب من الفيلم أشخاصاً، ونكره ونعادي غيرهم، وننحاز للبطل ضد أعدائه.
ما قبل التليفزيون كان فرصة عظيمة لنمو وثراء نعمة التخيل والتفكر، فكنا نسمع برامج الراديو ومسلسلاته الدرامية وبرنامج “أبلة فضيلة” وحواديت الأمهات والجدات ونحن مستغرقون في تخيل ما وراء الأصوات.
أما إنسان عصر ثورة الاتصالات المسكين، فقد حاصرته مطالب العيش كداً وكدحاً، ثم أسلمَتهُ في وقت فراغه محبوسا داخل جدران أربعة محاصراً بالصورة المتحركة أمامه في التلفاز أو في وسائل الاتصال الحديثة، ويترك أولاده نهباً لتلك الوسائط المرئية التي تقتل الخيال وتقود للكسل الفكري.
وكنت أنا ابن هذا الجيل المحظوظ خصب الخيال ورايق البال، دائما أبداً أسرح بخيالي في أفكار مبهجة تضع علامتها في ابتسامة على وجهي سواء في خلوتي أو حتى بين زحام الناس، يراني أخواتي البنات مختليا وحدي في غرفتي التي لا أغلق بابها أبدا، وأنا أبتسم وحدي ويتطور الابتسام إلى الضحك أحيانا، وهم يضربون كفا بكف ويطلبون النجدة من والدتي لتدارك الحالة الغريبة.!
وكان “مجدي” الذي بدأنا سويا في تعلم الكلام والانتقال من الزحف والحبو إلى المشي، كان يراني سائرا في الشارع وحدي في زحمة الناس وأنا مبتسم، فيفاجئني بالوقوف أمامي، أو جذبي من الخلف وهو يقول: “حودة .. أنت بتضحك لوحدك في الشارع.. الناس حتقول عليك عبيط.. أوعى تمشي لوحدك بعد كده.. ناديني وأنا انزل معاك”، وبرغم هذا؛ لا كلام أخواتي ولا تحذيرات “مجدي” كان لها أي جدوى، فما زالت هذه حالي بعد تعاقب عشرات السنين وظهور التجاعيد.
برغم الوقت الطويل الذي كنا نمضيه معا كأصدقاء، والأنشطة المشتركة الكثيرة التي كنا نمارسها، وبرغم نشأتنا في حي شعبي، إلا أنه كانت هناك حدود فاصلة من الاحترام لا يتم تجاوزها مهما كان الخلاف وما يتطور عنه من شجار، لم يحدث أبداً أي تجاوز لفظي بيني وبين “مجدي” الذي كنت لا أفارقه، وحين كنت أخاصمه لدقائق يصالحني بقوله: “حودة.. لا تنس إنك أول ما تعلمت الكلام قُلت: بابا وماما.. ومجدي”.