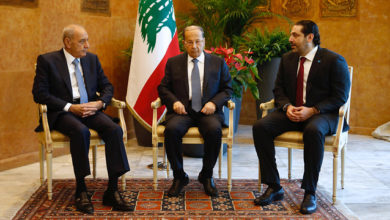هل تنجح دول المغرب العربي بطيّ صفحة الصراع في ليبيا؟ تحركات من أجل الحل السياسي، لكن الواقع صعب

شهد هذا الأسبوع مبادرة الدبلوماسية المغربية التي تميزت باستقبال رموز الفرقاء الرئيسيين في الملف الليبي، وهم: رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس البرلمان المنعقد بطبرق عقيلة صالح، في خطوة دبلوماسية تصبو إلى بلورة نسخة جديدة لاتفاق الصخيرات الموقع سنة 2015، نسخةٌ تراعي متغيرات الصراع بعد التدخل العسكري الدولي الداعم لطرفي النزاع، من جهة حكومة الوفاق ومن جهة قوات الجنرال حفتر.
ومن جهتها، حاولت الدبلوماسية الجزائرية طوال الشهور الأخيرة الوساطة بين الفرقاء خوفاً من تحول جارتها إلى “صومال جديد”، كما عبر عن ذلك مؤخراً الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خاصة بعد حشد “الوفاق” قواتها حول محيط مدينة سِرت.
وعلى مستوى الدبلوماسية التونسية، ورغم اختلافات مواقف الرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا على السلطة بالبلاد (المرزوقي، السبسي، سعيّد)، يبقى القاسم المشترك بينهم هو الحياد كاختيار استراتيجي لحل الملف الليبي.
وقد تستفيد التحركات الدبلوماسية المغاربية من الظرفية الدولية الداعمة لتهدئة الأوضاع بليبي، بحيث إن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تدفعان بقوة إلى حل سلمي يجنب البلاد تبعات تمزق يهدد أمن المنطقة وجيرانها بالمغرب الكبير وباقي دول جنوب الصحراء.
تاريخياً، المغرب لعب دوراً مركزياً لحلحلة النزاع الليبي عبر النجاح في بلورة اتفاق الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.هذا الاتفاق الذي استطاع أن يحظى بموافقة غرباء الصراع وتزكية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
شهد هذا الأسبوع عودة المغرب إلى المشهد الدبلوماسي عبر مساعٍ ترمي إلى التوصل لمخرج سياسي للنزاع الليبي، وذلك عبر استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس البرلمان المنعقد بطبرق عقيلة صالح. وتندرج هذه الزيارة ضمن الموقف المغربي المحايد المتكتم القاضي ببعث نفس جديد في اتفاق الصخيرات، الذي يرى فيه المغرب المرجعية الأساسية لكل حل سياسي في ليبيا.
فلا شك أنه بعد مرور خمس سنوات على التوقيع على هذا الاتفاق، تغيرت خريطة الصراع من جراء التدخل العسكري لفاعلين دوليين سواء لدعم حكومة الوفاق أو قوات الجنرال حفتر. وبعد الدعم التركي الحاسم لقوات حكومة الوفاق، تغيرت موازين القوى على الميدان بتراجع قوات حفتر بعيداً عن العاصمة طرابلس.
وبناءً على متغيرات النزاع عسكرياً، يتبنى المغرب موقفاً براغماتياً محافظاً على مسافة متساوية من جميع المتدخلين في الصراع الليبي مع إبداء الاستعداد لتطوير اتفاق الصخيرات وفقاً لمتغيرات الواقع السياسي الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق المبرم سنة 2015 نص على تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق إضافة إلى التمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
تأتي المبادرة المغربية الأخيرة مباشرة بعد تهديد مصر بالتدخل العسكري وإطلاق مبادرة إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار، وهي المبادرة التي رحبت بها كل من الإمارات والسعودية والأردن والبحرين، إلى جانب روسيا وبعض الأوروبية فيما تجاهلتها حكومة الوفاق ورفضتها تركيا.
الجزائر، الجار الذي يشترك حدوده مع ليبيا على امتداد 982 كلم، عبّر مراراً منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011 عن تخوفه من تحول البلاد إلى “صومال” جديدة أو إلى سيناريو مشابه لما حدث في سوريا.
دبلوماسياً، الجارة الجزائر حافظت على قنوات اتصال مباشرة مع فرقاء الصراع الليبي بالشرق والغرب مع التأكيد على الوقوف حياداً بين الأطراف المتنازعة.
ومع تزايد الدعم التركي لحكومة الوفاق وإعلان مصر نيتها التدخل عسكرياً بطلب من القبائل الليبية، حاولت الجزائر، مؤخراً، تكثيف جهودها الدبلوماسية خوفاً على أمنها القومي نظراً لطول الحدود المشتركة مع الجارة الليبية، وخطر تزايد التدخل العسكري للعديد من الدول في الملف الليبي.
وللتذكير، فمنذ بداية شهر يوليو/تموز تسعى الجزائر إلى إنضاج مبادرة سلام، بتنسيق مع تونس وبمباركة من الأمم المتحدة من أجل انتشال ليبيا من أزمتها. وهذه المبادرة وإن كانت غير واضحة المعالم، فإنها تدعو الفاعلين الليبين إلى حوار سياسي يفضي إلى تنظيم انتخابات جديدة وبناءٍ دستوري توافقي يمكن أن يرسي قواعد سلام دائم.
التحرك الجزائري، وكذلك نظيره المغرب، يحاولان الاستفادة من الاتجاه العام الذي تنحوه الدول المؤثرة في الملف الليبي للتهدئة. وبغض النظر عن حظوظ نجاح هذه المبادرة، يبقى دافع الدبلوماسية الجزائرية من تسريع وتيرة اهتمامها بالملف الليبي هو تزايد مخاوفها الأمنية من استمرار الحرب بليبيا. ففي حالة “صوملة” ليبيا، ستعاني الجزائر وتونس من غياب المؤسسات، وانتشار فوضى السلاح، وتنامي عدد الميليشيات المسلحة وذلك على طول الحدود الطويلة الفاصلة بين الجزائر وطرابلس.
وللإشارة، فإضافة إلى المبادرة الدبلوماسية، قامت الجزائر بزيادة نقاط التفتيش بين حدود البلدين ونشر قوات كبيرة للجيش وتسيير طلعات استطلاعية عبر الطائرات. وهذا الاستنفار الأمني مرتبط ليس فقط بالتهديد الليبي بل كذلك بتدهور الوضع الأمني شمال مالي.
على غرار الموقفين المغربي والجزائري، كان موقف الدبلوماسية التونسية مبنياً على الحياد منذ سقوط نظام القذافي، مع التأكيد على أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون داخلياً بعيداً عن مزايدات التدخلات الخارجية خاصة العسكرية.
تطور الموقف التونسي عبر مراحل. ففي عهد الرئيس المرزوقي، رفضت تونس عملية الكرامة التي قام بها الجنرال حفتر سنة 2014، معتبرةً هجومه انقلاباً عسكرياً يهدف إلى إجهاض تجربة المؤتمر الوطني كأعلى سلطة انتقالية منتخبة.
وفي عهد الباجي قايد السبسي (2014-2019) حاولت الدبلوماسية التونسية الرجوع إلى موقف الحياد الحذر مع السعي إلى تقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب.
أما الرئيس الحالي قيس سعيّد فقد حافظ على موقف الحياد مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي بين الأطراف بعيداً عن رهانات التدخلات الأجنبية.
إن تخوف تونس من تأجج لهيب الصراع الليبي مرتبط بتصاعد عمليات التسلل إليها من ليبيا وتهريب السلع من لبنان ما جعل الحدود الليبية التونسية، خاصة جنوب شرقي تونس، تتحول إلى مناطق عسكرية عازلة يُسمح فيها للجيش التونسي باستعمال كل وسائل التدخل. ومن المعلوم أن الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس تمتد على طول 400 كلم، ومنذ سقوط نظام القذافي حافظت تونس على انفتاحها، كملجأ إنساني، أمام اللاجئين الليبيين الهاربين من أتون الصراع المسلح بالبلاد.
لا شك أن تأثير الأزمة الليبية في تونس ليس أمنياً فقط، بل هو كذلك اقتصادي بامتياز. فليبيا هي الشريك الاقتصادي الثاني لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، والمزود الرئيسي لها بالبترول. ولم يكن استمرار تأزم الوضع الأمني بليبيا دون أن يؤثر اقتصادياً في تونس خاصة بالمناطق الحدودية إضافة إلى انهيار التحويلات المالية للجالية التونسية العاملة بليبيا.
حاولت فرنسا مراراً أن تلعب على تشتت المبادرات الدبلوماسية المغاربية لشحذ الدعم لموقفها المساند للجنرال حفتر. فعلى هامش كل زيارات المسؤولين المغاربيين لفرنسا، تحاول باريس الاستفادة من العلاقة التاريخية والشراكة الاقتصادية للضغط على دول المغرب الكبير من أجل اتخاذ موقف حازم ومعارض للدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق.
لقد ألقى الخلاف التركي الفرنسي بليبيا بظلاله على دول المغرب الكبير التي أصبحت بعد حوالي 10 سنوات من اندلاع النزاع الليبي عاجزة على التأثير إيجاباً في مسار تطور النزاع الليبي على الأرض.
ولا شك أن الموقف الفرنسي يحرج إلى حد كبير شركاءها المغاربيين على اعتبار أنه يهدد أمن المنطقة ويسرع من تحقيق شبح صوملة ليبيا أو تكريس حرب أهلية كما هو الحال في سوريا.
الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المغرب والجزائر وتونس لن تتوج بالنجاح المأمول إذا لم تحظَ بدعم القوى الفاعلة ميدانياً التي لديها حضور عسكري على الأرض، خاصة بعد فشل هجوم القوات الجنرال حفتر على طرابلس شهر أبريل/نيسان 2019 نتيجة الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق. ورغم اتفاق دول المغرب الكبير على الحياد للتوصل لحل سياسي ليبي ـ ليبي، إلا أن ما يضعف مختلف المبادرات المغاربية هو أن كل بلد على حدة تحاول تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ولكن دون أدنى تنسيق فيما بينها.
ولعل هذا التشتت الدبلوماسي والمقاربة الأحادية لردع الصدأ بين الفرقاء الليبيين قد أضعف قوة الضغط المتاحة لدول المغرب الكبير أمام اتساع الدعم التركي، والقطري، والإيطالي لحكومة الوفاق مقابل الدعم الإماراتي والسعودي والمصري والروسي، والفرنسي، لقوات الجنرال حفتر.
وبناءً على ما سبق، فإن حظوظ ولادة نسخة 2.0 لاتفاق الصخيرات تبقى واردة لكنها صعبة بسبب ضعف التنسيق المغاربي أمام ميزان القوات العسكرية المتدخلة بشكل مباشر ميدانياً.
لا شك أن النزاع الليبي لن يحل بمواقف الحياد وحدها بل بالقدرة على التأثير في موازين القوى العسكرية على الأرض للتمكن من تبوؤ موقع قوة في مختلف محطات التفاوض بين فرقاء النزاع.
ورغم شتات المبادرات الدبلوماسية الصادرة عن دول المغرب الكبير، فإن اتجاه العديد من الدول المؤثرة عسكرياً ومالياً في الملف الليبي المائل إلى ترجيح مسار التهدئة قد يكون فرصة لإعطاء زخم لمبادرات الرباط والجزائر وتونس للتوصل إلى حل للأزمة الليبية بما يرضي جميع الأطراف.