

باديـــة شكاط
ممثل الجزائر في منظمة اعلاميون حول العالم الدولية
عضو مؤسس والأمين العام للمنظمة
يقول تبارك وتعالى:”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ” سورة الروم الآية 41
فحين تحولت الأرض إلى حلبة عريضة للمبارزة المريضة،التي يريد من خلالها الطغاة الإستبداد بكل ماأوتوا من معاول الخراب والفساد،دون أية قيود تمسكهم أو سدود تذوذهم،لم تعد البشرية تعلم أيان تسير فهي تلقى نحو الفناء ذات المصير،ففي كتاب “ازمة المناخ والصفقة الخضراء العالمية الجديدة:الإقتصاد السياسي لإنقاذ الكوكب” لتشومسكي وبولين،يقول نعوم تشومسكي:”لاهوادة في سعي الطبقات المجرمة وراء السلطة والربح،مهما كانت العواقب البشرية،وستكون هذه العواقب وخيمة إذا لم يتم التصدي لجهودها،وهزيمتها في الواقع،من قبل أولئك المعنيين ببقاء البشرية”.

فرغم العديد من القوانين والإتفاقيات الدولية حول المناخ،التي أقرّت من خلالها 154 دولة بحدوث تغيُّر مناخي بشري المصدر،وقررت بعدها أن تضافر جهودها لأجل الحدِّ من الاحترار العالمي كقمة ريو دي جانيرو 1992،الذي انبثقت عنه “إتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ” التي هدفت إلى
تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي،عند مستوى يحول دون أي مخاطر مناخية،ورغم مصادقة 192 دولة على توصياتها،إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدّق على البروتوكول مطلقاً،في الوقت الذي فرض الإلتزام بتطبيقه على 37 دولة بمعدل عام يبلغ نسبة 5 في المائة،وتخفيض الانبعاثات بمعدل 8 في المائة للاتحاد الأوروبي،أما سائر البلدان فلم تلتزم بمعدلات محدّدة بل أُشركت في عملية مكافحة تغيُّر المناخ عبر آليات تحفيزية،وإلى يومنا هذا بقي التمايز واضحًا والتفاوت صارخًا في الإلتزام بمثل هذه الإتفاقيات،وهذا بسبب غياب التوافق السياسي بشأنها،وكذا عدم الإهتمام بالسلامة البيئية المنصوص عليها عند حساب حصص الإنبعاثات،والأمر ذاته بالنسبة لغيرها من الإتفاقيات التي تؤثر على البيئة،فمثلا فرنسا تريد فرض استخراج الغاز الصخري من الصحراء الجزائرية،في حين هي تمنع استخراجه من الأراضي الفرنسية،وذاك حفاظا على سلامتها البيئية وتحقيقًا لمصالحها الإقتصادية،وجميع تلك الصور هي صورة واحدة لانسلاخ الإنسان من الإنسانية،وتدحرجه الى دركات الحيوانية،يقول المفكر علي عزت بيغوفتش في كتابه “هروبي إلى الحرية”:
“المصلحة حيوانية أما التضحية فهي إنسانية”
فلم تعد البشرية إذن بحاجة الى قوانين ومواثيق دولية لتحمي بها الانسان من شر الإنسان فحسب،بل صارت أحوج الى ضوابط تعرّف بماهية الشر،فأن يكون الشر غير قابل للقياس كفعل إلا من خلال الفاعل،فيصبح الفاعل هو المحدِّد لأوجه الخير والشر،يقلبها كيفما يشاء،ذات الخير وذات الشر،فهذا حمل للمتناقضات في سلة من المعايير واحدة،مايجعلنا بحاجة إلى ضبط مفهوم الشر،فضبط مفهوم الشر هو ماينضبط من خلاله سلوك الإنسان،كما معيارية الخير والشر لديه،وكمثال على ذلك مانراه يتكرر في فرنسا،حين تجعل من الفعل الإرهابي الواحد شرًا إذا ارتبط بالدفاع عن مقدسات دينية،وليس بشر إذا تعلق بقتل شخصيات إسلامية،فالوحشية في فرنسا هي الدين إذا كانت ضد الدين الإسلامي،أو كما قال نعوم تشومسكي:”العلمانية دين وضعي والعلمانيون متدينون بها،يجعلون من الدولة ربا ويقاتلون الإنسانية بكل وحشية من أجل فرض سياستها“.

وكذلك الأمر بالنسبة للأسلحة النووية التي تحرّم على دول دون أخرى،فهذا التمييز السيادي الإستعبادي لم تتساقط كرات نيرانه على مساحات إقتصادية،او سياسية أو اجتماعية فحسب فأحرقتها،بل أحرقت كل جوانب الحياة البشرية ،فلم تبق ولم تذر،مايجعل الإنسان في بحث دؤوب عن زورق نجاة يخرجه من جميع دوائر الشر تلك،ورغم أنه قد سبق للمفكرين أن حددوا دوائر الشر وحصروها في دائرتين هما:
دائرة شر طبيعي و دائرة شر أخلاقي:حيث جعلوا الشرور الطبيعية هي تلك التي رآها الانسان ماثلة أمامه في الكوارث التي تضرب بالطبيعة أو الأمراض التي تفتك بجسده.
وأن الشرور الأخلاقية هي كل مانأت به عن النزعات الأخلاقية،وباءت بنوايا الفاعلين الأخلاقيين،كالقتل والإستبداد،والفساد وغير ذلك،فإننا نرى ضرورة إضافة دائرة شر ثالثة:
وهي برأيي الدائرة التي تتداخل فيها دائرة الشر الطبيعية بدائرة الشر الأخلاقية،فيحدث شر يبدو وكأنه طبيعي بينماهو بنوايا أخلاقية انسانية،كعبث الإنسان بالطبيعة،ومايفعله بالمناخ،أومايبثه فيها من أوبئة جرثومية،أو يحتقر فيها ذاتًا انسانية،لمجرد تجرُّد من ماهيته الحقيقية،واستعلاء فارغ على كل من يقاسمه البشرية.
فخطاب أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين الذي في القرآن الكريم،وحي لايزال يتنزّل على الأنفس الشيطانية،لتصير العنصرية،الكراهية،القتل،التدمير مشروعة بشرعية الأفضلية،فأن تكون مثلا من عرق إفريقي،أو بعقيدة اسلامية،فإنك حتمًا ستتحول الى شر وجب إبادته دون مبالاة بدعوى الحرية،كما تسلب منك بشكل طبيعي جميع مواردك الطبيعية،بل وتمارس أيضا عليك التجارب النووية كما فعلت فرنسا الوحشية في صحراء رقان بالجزائر أثناء الحقبة الإستدمارية.
فالهوية الإنسانية قد طمست بالفعل بدعوى الحرية،في حين الله عز وجل قد منح الإنسان الحرية ليميز الخير من الشر،وليس لتكون الحرية ذريعة له ليمارس كل شر.
ورغم توجيه الكثير من النقد للفيلسوف نيتشه وأمثاله من الذين لايرون جدوى من تحديد مفهوم للشر،إلا أنه لاينبغي أن نغفل أمرًا غاية في الأهمية،ألا وهو تفسير دافع الشر نفسه،فهناك من يرى دافع شره خيرا بينما هو بالنسبة لغيره شرًا،وهذا يجعلنا ندرك تمام الإدراك أنّ ماهية الخير والشر لاتتحدد أبدًا من خلال الدوافع،وإلا فإننا سنجعل من الميكيافيلية قيمة أخلاقية تحدد معيار الخير مقابل الشر،بينما الذي يحدث أن الإنسان كائن مركب من عوامل مادية وأخرى روحية،وكلما جنح إلى المادية حلّق بعيدًا عن القيم الأخلاقية بوصفها إحدى الدلالات الروحية.
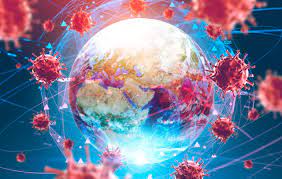
فتمركز الإنسان حول المادة جعله وهو يحاول الإبقاء على الإنسان أفنى الإنسانية كقيمة روحية،وقد بدأ هذا الفناء تدريجيًا من مرحلة حاول فيها الإنسان أن ينفصل عن الذات الإلهية،بالتمركز حول ذاته،فصار يعتقد أن لاوجود لإله يقبل كل هذا الشر الذي يحدث في العالم(غير مدرك أن الإله قد جعل الخير والشر مخلوقين،وإلا لتناقض ذلك مع ذاته العلية،فلو كان الخير مطلقًا لكان إلهًا،فلا مطلق إلا الله)،ثم بعد أن فشل في مرحلة فهم الغاية من خلق الشر والخير وماملّكه الله عز وجل من حرية،إنتقل إلى مرحلة الإنفصال عن الدين،وأسّس لنفسه المركزية،فجعل من نفسه غاية وكل ماسواه هو مسخّر لخدمة هذه الغاية.
فظهرت الإمبريالية الإستعمارية المتوحشة كمركزية كبرى فيها امتدت مركزية الإنسان إلى مركزية أمة،فصار يمكن لأمة تؤمن بغائية هذه المركزية أن تبيد أمة أخرى،وظهرت تباعًا لذلك النزعات العنصرية التي حوّلت أممًا إلى وسائل تخدم مصالح أمم أخرى،وظهرت حركات كالنازية والفاشية والصهيونية،..إلخ
ثم عاد الإنسان إلى المركزية الصغرى التي منها انطلق،وصار يبحث عن صورة من الألوهية،فيها يكون هو السيد كفرد على مجموعة من الأفراد،فيُحيي ويُميت،يغني ويفقر،…دون أن يرمق في ذلك أي وجه من وجوه الشر،بل يراه غاية كبرى من غايات خلق البشر.

وفي هذه الأثناء من فقد الإنسان إلى جوهره،راح يبحث له عن انتماء،تتحدد سماءاته بما أراه برؤيتي المتواضعة في ثلاثة أصناف:
الصنف الاول:هو ذاك الإنسان الذي يزيده الفقد تمسكًا بذاته،فيجعل أناه مركزًا وكل شئ حولها يدور،فيطمع في الحصول على سعادة لها مضاعفة بسلبها من الضعفاء،ويطغى ويستبد ليغذي أنانيته،ويجعلها تكبر في حيّز من الوهم،يشعره أنه أكبر، فيعبث بكينونته وهويته في سبيل رؤية زائفة للذات،صوّرت الجوهر كمحور يتحرّك حوله العالم من شرقه إلى غربه،دون توقف لصناعة مواقف حقيقية، فكل المواقف لديه هي فرعونية فارغة ومجرد سلطة جلاد،يتقن بسوطه جلد الضحية،ويرى في ذلك كامل الإستحقاق،دون أن يبحث عن الحق أو الحقيقة،فالحقيقة حاضرة دومًا في جوهره المظلم الذي عرف إليه الظلم ألف سبيل،من غير حجة أو دليل،فجعل من ذاته الإله الذي يستحق القداسة والعبودية.
الصنف الثاني: فهو من يبحث عن جوهره في غيره،بعد أن شعر بفناء ما فيه،فراح يفتش عن الكمال خارج ذاته ليكتمل بذاته، فينصهر في مثيل له وشبيه،أو ضدٍ له ليحاكيه،فيجد إمتدادًا آخر لجوهره يشعره بديناميكية الحياة،وبنوعٍ من محاربة الفناء باتصالٍ مع البقاء،فيقدّم الخدمات الإنسانية التي تشعره بجوهره الإنساني،ويساهم بالحفر العميق في كل التجارب التي تشعره بالإنتماء،فتراه يتحمس للعرق أو الجنس أو الطائفة أو غيرها،ويتنطع بتقدير جوهره الذي لم يكن شطره،إلا محض انشطارٍ للحظة انتماء إلى غيره.
الصنف الثالث:فهو من عرف حقيقة جوهره،فعالج النقص فيها بما اكتشف من نقص في غيرها،فحين اكتشف أناه الأنانية هذّبها بما يراه من انعكاسات لها في غيرها،فكان الغير مرآة يهذّب بها جوهره،لا جوهرًا يهذّب به غيره،فأصبح يتجلى في كل ذاتٍ بصفاته من غير استبداد ولا استعباد،وتلك هي القدوة التي تمتثل فيها الذات الحرة في جواهر عديدة،دون أن تمتثل هي إلى غيرها،فبين المثال والإمتثال،وبين العطاء والإكتفاء يصنع الجوهر في هذا الصنف لحظة أبدية تبدّد معها كل خيوط الفناء،فهذا هو الجوهر وهذا ماينبغي أن يبحث عنه الإنسان،ليكون فقط إنسان،وهو لمسناه في جوهر الرسل والأنبياء،و في صفوتهم سيد الخلق رسولنا عليه الصلاة والسلام،قال تبارك وتعالى:” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللَّه أُسْوَة حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِر” الآية 21 من سورة الأحزاب

فالإنسان في هذه الحياة يعيش لحظة فارقة إما أن يحمل فيها جوهره وهمًا بالفوقية سحيق،وإما أن يحمل فهمًا للجوهر عميق،فتتحول فيه اللحظة إلى عمر،والعمر إلى تاريخ،والتاريخ إلى لحظةٍ أبدية لاينجو فيها الإنسان لوحده،بل تنجو كل الإنسانية.
وهنا تتجلى عظمة دين الإسلام الذي جعل السلام لحظة بقاء،لاتتحقق إلا بأن يساوي فيها إنسان واحد كامل البشرية،فكما يقول المفكر مصطفى محمود رحمه الله:” إحترام الإسلام للفرد بلغ الذروة،وسبق ميثاق حقوق الإنسان وتفوق عليه،فماذا يساوي الفرد في الإسلام؟ إنه يساوي الإنسانية كلها”
قال تبارك وتعالى:”مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ” الآية 32 من سورة المائدة.

بادية شكاط كاتبة في الفكر،السياسة وقضايا الأمة
الأمين العام لمنظمة “إعلاميون حول العالم”




