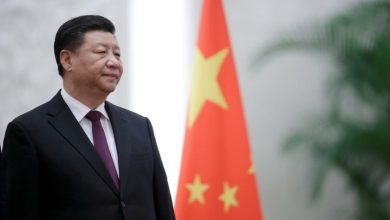اليمين المتطرف ومكافحة الهجرة.. كيف أصبحت حماية الحدود من المهاجرين أهم من حياة البشر؟

تزامن الصعود الصاروخي لتيار اليمين المتطرف في الغرب مع تنامي اللغة المضادة للهجرة والمهاجرين، وأصبح الإنفاق كبيراً على تأمين حدود تلك الدول وتشديد الرقابة منعاً لوصول المهاجرين وهو ما أدى لتكرار المآسي وفقدان كثير من البشر حياتهم، فهل أصبح تأمين الحدود أهم من الحياة البشرية ذاتها؟
مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناولت القضية في تقرير بعنوان: «هوس الدول الغربية بأمن الحدود يُفاقم انعدام الاستقرار»، ألقت فيه الضوء على مخاطر تلك السياسة على الدول الغربية نفسها على المدى البعيد.
منذ فترةٍ طويلة للغاية، يُفلِت القادة الغربيون من العقاب على أفعالهم الوحشية باسم أمن الحدود. فمن الساسة اليمينيين المتطرفين إلى الأحزاب السابقة الموالية للمؤسسة، صارت «محاربة الهجرة غير الشرعية» هي اللعبة الجديدة من كانبيرا إلى واشنطن مروراً ببروكسل وروما. وفي حين أنه من الطبيعي أن يُثار الغضب بسبب حبس الأطفال في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب أو تجريم عمليات الإنقاذ في إيطاليا بقيادة وزير الداخلية ماتيو سالفيني، تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه اللعبة القاتلة لا تقتصر على بضعة ساسة شواذ قساة القلب مع الأسف، بل أصبحت ممنهجة.
ومنذ سنواتٍ عديدة حتى الآن، يعد الجزء الرئيسي من اللعبة هو إقناع الدول المجاورة الأفقر بتولي المهمة القذرة المتمثلة في ردع الهجرة، وصحيحٌ أنَّ المكاسب السياسية على المدى القصير لهذه الاستراتيجية تعد هائلةً في في كثيرٍ من الأحيان، لكنَّ الاستعانة بمصادر خارجية لردع الهجرة والسيطرة على الحدود لها نتائج عكسية سلبية، على الصعيدين الإنساني والسياسي.
ولننظر إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. ففي تقريرٍ نشرناه في يوليو/تموز الماضي، أوضحنا بالتفصيل كيفية استعانة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بجهات خارجية -مثل تركيا وليبيا والنيجر- لردع الهجرة، وما أسفر عنه ذلك من عواقب وخيمة نادراً ما تجري مناقشتها.
فبفضل الإحصاءات التي توضِّح انخفاض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية عن الأعداد القياسية المرتفعة في عام 2015، يتغنَّى الساسة بالنجاح المزعوم في محاربة الهجرة عبر الدوريات والأسوار والردع الشديد، ويفلتون من العواقب الوخيمة. فيما تقبَّلت معظم وسائل الإعلام قصة النجاح المزعوم بحماسٍ كبير بتقليل تقاريرها عن الهجرة، بينما التزمت الأصوات الأكثر تقدمية الصمت خوفاً من إثارة الوحش اليميني المتطرف. غير أنَّ هذا النجاح الزائف يخفي فشلاً أخلاقياً وسياسياً أكبر بكثير من شأنه أن يطارد الاتحاد الأوروبي لاحقاً.
فمن احتجاز المهاجرين إلى أجلٍ غير مُسمَّى في ما وصفته منظمة العفو الدولية بمخيماتٍ «غير آمنة وغير لائقة» في اليونان إلى عمليات ردع المهاجرين ودفعهم نحو جحيم ليبيا، ومن الطرق المحفوفة بالمخاطر المتزايدة في الصحراء الكبرى إلى حوادث الغرق الجماعي التي كان يمكن تجنبها في البحر الأبيض المتوسط، أثار ما يُدعى بـ»مكافحة أوروبا للهجرة غير الشرعية» انتهاكاتٍ تقوض الدور العالمي للاتحاد الأوروبي وقِيَمه المعلنة.
ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، التمسُّك بهذه الاستراتيجية، ففي أجندته الاستراتيجية الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة، تتضافر جهود أعضائه حول مشروعٍ يبدو مطابقاً لإرشادات كُتيب قواعد التيار اليميني المتشدد؛ إذ يهدف إلى حماية الحدود، وليس الناس. وعلى حد تعبير الأجندة، فالمسار نحو التقدم يتمثل في «مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن طريق تعاونٍ أفضل مع البلدان الأصلية والبلدان التي يمر عبرها المهاجرون».
أي أنَّ الاستراتيجية بسيطة: إضفاء طابعٍ خارجي على المشكلة. وكما أشارت منظمة مجلس أوروبا، فذلك تتطلَّب الاستعانة «بدولٍ ثالثة لديها سجلاتٌ سيئة في حقوق الإنسان من أجل السيطرة على الحدود». وبعبارةٍ أبسط: اضمن بقاء التهديد بعيداً -بعيداً عن الأنظار والأذهان- بتصدير تكاليف ومخاطر مكافحة الهجرة إلى هذه البلدان. وافعل ذلك حتى لو اقتضى تقديم أموالٍ نقدية جاهزة أو تنازلاتٍ سياسية لأنظمةٍ بغيضة ما دامت مستعدة لتولي المهمة القذرة المتمثلة في ردع الهجرة بالاحتجاز غير الإنساني والطرد التعسفي ومنع السفر بطريقةٍ قاسية وما إلى ذلك.
وصحيحٌ أنَّ بعض الجماعات الحقوقية توثِّق، منذ سنواتٍ عديدة، أمثلةً على المعاناة الناجمة في فناء أوروبا الخلفي عن هذه الاستراتيجيات، وأنشأت قوائم بالوفيات الناتجة عن سياسات ردع الهجرة إلى أوروبا منذ عام 1993 تجاوزت 30 ألف ميت حتى الآن، وما زال العدد في زيادة. ولكن من الصعب بالفعل الكشف عمَّا يحدث للأشخاص الذين يتعرضون للطرد في عمق الصحراء الكبرى أو الأشخاص القابعين داخل مراكز الاعتقال الوحشية في ليبيا، التي تتلقى دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي.
وبذلك تبقى المعاناة مخفيةً وبعيدة حتى يصل العنف الشديد إلى الأخبار، مثل حادثة مقتل 44 شخصاً على الأقل في يوليو/تموز الماضي إثر غارةٍ جوية شنَّها الجنرال الليبي خليفة حفتر على مركز احتجاز في طرابلس. غير أنَّ حالة الصمت العام هذه تُسفر عن تفاقم المعاناة إلى درجةٍ قد تلحق ضرراً بعلاقات الدول الأوروبية مع جيرانها، لا سيما وأنَّ بعض الجيران ينتبهون إلى هذه الاستراتيجية التشاؤمية. وقد لخَّصت أميناتا تراوري وزيرة الثقافة السابقة في مالي، الناشطة بارزة في قضايا الهجرة، الوضع بإيجاز حين قالت: «أوروبا تتعاقد من الباطن مع أطرافٍ أخرى لتنفيذ المهام العنيفة في إفريقيا».
بعبارةٍ أخرى، فبينما يفوز الاتحاد الأوروبي في حربه المُعلنة على الهجرة، يخسر حرباً أهم بكثير على النفوذ، ويقوِّض القيم التي من المفترض أنَّها تدعم المشروع الأوروبي، ويُضعِف نفوذه الدبلوماسي في الخارج. والأسوأ من ذلك أنَّ إبعاد المشكلة عن أوروبا مؤقتاً يزرع بذور الانتهاكات والقمع، بل وانعدام الاستقرار، على نطاقٍ أوسع بكثير.
ولعل إحدى الطرق التي يحدث بها ذلك هي تصعيد القضية. فحالما تُعامَل الهجرة على أنَّها تهديدٌ وجودي لـ»نمط الحياة الأوروبي»، سيعرف أولئك الذين يعيشون في الدول المجاورة للاتحاد كيفية الاستفادة من هذا التهديد بطريقةٍ فعالة، مما سيسفر عن عواقب مزعزعة للاستقرار.
ولننظر على سبيل المثال إلى تركيا، إحدى الدول التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لردع الهجرة. إذ يرضخ الاتحاد الأوروبي لقبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المُحكمة على سلطة البلاد، مقابل التزامه تنفيذ بنود اتفاق ردع الهجرة الذي أُبرِم بين تركيا والاتحاد الأوروبي بداعي خوف الاتحاد من المهاجرين. ومن جانبه يلعب الرئيس التركي أوراقه بذكاء ضمن القواعد التي أسَّسها هوس أوروبا المتزايد بقضية الهجرة، لذا هدَّد أردوغان الاتحاد الأوروبي صراحةً، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ «فتح البوابات» أمام اللاجئين للتوجه نحو أوروبا إذا امتنع قادة الاتحاد الأوروبي عن دعم عمليته العسكرية في شمال سوريا وإعادة توطين اللاجئين هناك.
أو لننظر إلى السودان، حيث تتغنَّى قوات الدعم السريع في البلاد، وهي مجموعة شبه عسكرية كانت مرتبطة بقوات الجنجويد التي ارتكبت الإبادة الجماعية في دارفور، بقدرتها على محاربة الهجرة. وهذه هي القوات نفسها التي قتلت عشرات من المتظاهرين بالخرطوم في وقتٍ سابق من العام الجاري (2019)، والتي أصبح زعيمها بحلول الصيف الماضي، القائد الفعلي للبلاد بدعمٍ من السعودية، وفقاً لمعظم الروايات.
وصحيحٌ أنَّ قادة الاتحاد الأوروبي أوقفوا التعاون مع السودان في مجال مكافحة الهجرة، وسط هذه الاضطرابات، وأصروا على أن الاتحاد الأوروبي لم يدعم قوات الدعم السريع قط، لكنَّ هذه الخطوة تبدو ضئيلةً جداً ومتأخرة للغاية؛ إذ لعبت قوات الدعم السريع، مثل أردوغان، لعبةً ذكية ضمن القواعد التي أقامها هوس الاتحاد الأوروبي، وقدمت نفسها على أنها مُساعِدةٌ للاتحاد الأوروبي على الوفاء بأولوياته، في حين تعمل بأنشطة التهريب في الوقت نفسه. ويمكن القول إنَّ أمن الحدود مُنِح أفضلية مميزة في السوق السياسية، وهو ما ساعد المجموعة المسلحة على الحصول على حصةٍ أكبر بالسوق.
وهذا لا يحدث بالسودان فحسب، بل في جميع مناطق الساحل الإفريقي والقرن الإفريقي، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي يُقدِّم أموالاً طائلاً متعلقة بمكافحة الهجرة واعترافاً سياسياً بأنظمةٍ مشبوهة وقواتها الأمنية التي تمارس ممارساتٍ قمعية متكررة. وأحد هذه البلدان المستهدَفة النيجر، التي أصبحت مُختبراً لأمن الحدود؛ وهو ما أسفر عن عواقب وخيمة.
فالقانون الصارم الذي فرضه الاتحاد الأوروبي هناك بشأن تهريب المهاجرين، لم يؤثر فقط في تهريب البشر عبر الحدود، بل أثَّر في جميع أنواع التنقل عبر البلاد، وضمن ذلك الممارسات الانتقائية التي تمارسها سلطات النيجر ضد أعضاء جماعاتٍ عرقية. وهذا يُهدِّد النيجر بتأجيج المظالم العرقية والسياسية، وحرمان شمال البلاد من شريان الحياة الاقتصادي، الذي لا يشمل الهجرة غير الشرعية فقط، بل يؤثِّر كذلك في التجارة العادية عبر الحدود مع ليبيا والسفر إليها.
وفي الوقت نفسه، يُغدِق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالأموال على جهاز الأمن في البلاد، دون توجيه أي أسئلة. إذ طلب رئيس البلاد المكروه، محمد يوسفو، مليار يورو لوقف أنشطة الهجرة غير الشرعية، وبعد ذلك بوقتٍ قصير، قدَّم له الاتحاد الأوروبي المبلغ المطلوب بالكامل، مُظهِراً بذلك لأي دولةٍ شريكة راغبة في ردع الهجرة مدى عدم اهتمامه بقِيمه المعلنة، ومتجاهلاً فشل حكومة النيجر في إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي ظل الاستياء الشعبي المتزايد، ومع وجود دولةٍ أمنية مُتجرئة واقتصاد مترنِّح، أصبح الوضع في النيجر قابلاً للاشتعال في أي لحظةٍ، ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى التدابير الأمنية نفسها التي فرضتها أوروبا.
أو ثمة نموذج آخر وهو ليبيا، التي اعتُبرت على نحو غريب، في بعض الأحيان، شبيهة بتركيا والنيجر كدليل على نجاح مكافحة الهجرة خارج الحدود. واعتماداً على الاتفاق الخبيث الذي أبرمه الزعيم الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي قبل عقد من الزمن، حاولت إيطاليا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، الالتفاف على المسؤوليات القانونية المتعلقة بالأنشطة البحرية، من خلال تمويل وتدريب ما يسمى خفر السواحل الليبي، الذي يعد جزءاً كبيراً منه واجهة للميليشيات المنمقة.
وتدفع هذه القوات الناس إلى العودة لعهد السجون والاعتقالات الخطيرة في ليبيا، التي تعصف بها الصراعات المتجددة والتي يشكّل المهاجرون فيها هدفاً رئيسياً، حسبما ذكرت سالي هايدن مؤخراً بمجلة فورين بوليسي. وفي الوقت نفسه، أوضحت التقارير أنَّ تنازع الميليشيات بحثاً عن موقع لمكافحة الهجرة نيابةً عن أوروبا، يهدد بزيادة الفوضى التي أعقبت الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» والإطاحة بالقذافي في عام 2011.
ويرى منتقدون أن هذه الصراعات ربما تبدو ثمناً زهيداً مقابل إبعاد المهاجرين، مثل الحل الأسترالي خارج الحدود لاستخدام دول المحيط الهادئ الفقيرة كمواقع إيواء لأجَل غير مسمى، أو ضغط ترامب على المكسيك ودول أمريكا الوسطى والذي يبدو قاسياً ولكنه ضروري. لكنَّ زعم الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي أن «مكافحة الهجرة غير الشرعية» بهذه الطريقة ضروري للدفاع عن «الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها»، هو محض خطأ. وبنظرة خاطفة إلى الاتجاه السائد عام 2015 -عندما وصل نحو مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا عبر البحر- يظهر أنه كان استثناءً: فمعظم المهاجرين يدخلون أوروبا جواً، وظل معظم المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى داخل منطقتهم.
والأهم من ذلك أن الحراك البشري لا يشكل في حد ذاته تهديداً لسلامة أي شخص. ففي الواقع، تكمن المخاطر المرتبطة بأكثر مظاهره فوضوية، إلى حد كبير، في التدابير الأمنية التي تُتخذ لوقفه. ولكن حتى هذه المخاطر الناتجة عن أفعال البشر تتضاءل مقارنة بخطر دعم الأنظمة الاستبدادية والقوى القمعية، في ظل تقويض نفوذ الاتحاد الأوروبي وقِيمه، تحت ذريعة أمن المواطنين الأوروبيين.
وهناك نوع آخر من سياسات الهجرة محتمل الحدوث في أوروبا وأماكن أخرى. وفي الواقع، يعد هوس أمن الحدود أمراً حديثاً إلى حد ما وبعيداً عن الحتمية. وبدلاً من تصاعد مخاوف أمن الحدود والمخاوف السياسية حول الهجرة، يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة إحياء المشروعات الإيجابية للتعاون والفرص، وضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العمل مع الاتحاد الإفريقي في خططه الناشئة لتعزيز حرية الحركة بجميع أنحاء القارة. ويتعيَّن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ضمان دعم الاستقرار ومنع الانتهاكات، كما كان الحال مع ليبيا قبل تدخل الناتو الكارثي هناك.
ويمكن بسهولةٍ تصوُّر خطوات مماثلة في أي مكان آخر. فعلى سبيل المثال، تستطيع واشنطن التصدي للهجرة باتجاه الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، من خلال السعي الحقيقي لوقف التواطؤ الأمريكي طويل الأمد في حالة عدم الاستقرار التي تعصف بأمريكا الوسطى، سواء من حيث دعم جماعات العنف وزعماء الانتهاكات أو من حيث تصدير أفراد العصابات إلى السلفادور. وهناك حاجة إلى تحوُّل مماثل في حرب المخدرات التي تعصف بالمكسيك، حيث أسهمت الأسلحة والتدخلات الأمريكية في تأجيج العنف الذي أودى بحياة آلاف.
ولكن لكي تحدث مثل هذه التغيرات بالسياسة، يجب أولاً أن يحدث تغيُّرٌ جذري في تفكير الغرب بشأن الهجرة. ويتعيَّن أن تتكاتف القوى التقدمية معاً على جانبَي الحدود، لإعادة صياغة النقاش. فالصراع الآن بين الحقوق والأمن، أو بين فتح الحدود وإغلاقها، يُصوِّر الموجودين في الجانب الأول على أنهم مثاليون ساذجون، والموجودين في الجانب الآخر على أنهم واقعيون متشددون. ومع ذلك، هذا فصل خاطئ.
إن الهوس بحماية الحدود، وتصعيد مكافحة الهجرة، هما في الواقع خيار أيديولوجي يخلق لعبة خطيرة. فإذا كان متخذو القرار والناخبون يريدون أن يكونوا «واقعيين»، فمن الضروري تقدير كافة التكاليف المستقبلية كافة للمسار الذي يتبعونه حالياً، والاعتراف بخطر محفزات تصعيد العنف والابتزاز والحكم الاستبدادي. وفي الوقت نفسه، فإن تصوُّر حماية الديمقراطيات الغربية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لمكافحة الهجرة، يغذي الوهم المدمر بأن هذه الدول يمكن أن تُجنِّب نفسها الوقوع في مشاكل مثل الصراعات والاحتباس الحراري الذي تسهم فيه بقوة.
والخطوة التالية هي اقتراح إطار آخر. فبدلاً من إذكاء عدم الاستقرار في الخارج، وتطبيع السياسة القومية الصارمة بالداخل من خلال الهوس بمزيد من أمن الحدود على المدى القصير، هناك خيار أفضل يجب اتباعه، وهو خيار يتضمن حماية الناس، وليس الحدود. ولذا يجب أن يبدأ المواطنون المستنيرون والزعماء السياسيون في إبراز أهمية ذلك.