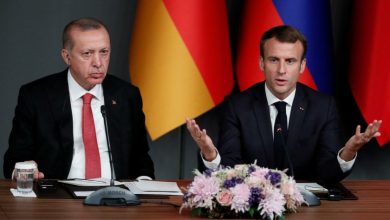من الأكثر استفادة من الآخر.. الخليج أم الفلسطينيون، كيف جعلت القضية الفلسطينية السعودية من أغنى دول العالم؟

مَن استفاد أكثر من الآخر، أنظمة الخليج أم الفلسطينيون؟ بات هذا السؤال المحرج مطروحاً للأسف على الساحة العربية.بعد تصريحات الأمير السعودي بندر بن سلطان، التي هاجم فيها القادة الفلسطينيين، وتصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور التي هاجم فيها الفلسطينيين أنفسهم لأنهم يلقنون أبناءهم ضرورة التمسك بحق العودة.
وهي تصريحات لا تستند إلى أي أساس علمي أو تاريخي، بل هي تنافي وقائع تاريخية معروفة للجميع.
ولكنها تأتي في إطار محاولة بعض قادة دول الخليج وأتباعهم رسم صورة غير حقيقية للعلاقة بين الفلسطينيين ودول الخليج واختلاق عداء زائف، في محاولة لتغطية هرولتهم للتطبيع مع إسرائيل بطريقة تخالف المبادرة العربية للسلام، التي هي في الأصل سعودية طرحها الملك السعودي الراحل عبدالله، عم الأمير محمد بن سلمان، عندما كان مثله ولياً للعهد والحاكم الفعلي للبلاد في مطلع القرن الحادي والعشرين.
في هذه الصورة يحاول هؤلاء خلق نزاع وهمي بين هوية خليجية تشكو من ظلم الفلسطينيين لهم، مع اتهام القادة الفلسطينيين بتضييع فرصة تاريخية، والتلميح إلى تضحيات كبيرة قدمتها دول الخليج مقابل إنكارمن جانب الفلسطينيين، وهي أمور غير حقيقية.
فالسلطة الفلسطينية تتمسك بمبادرة السلام السعودية المنشأ، والسلطة التي تتنافر بتركيبتها الفتحاوية مع إيران وتركيا، اللتين يحكمهما الإسلاميون، تريد الحفاظ على علاقتها مع الأنظمة العربية التي تشبهها وتشبههم.
ولكن المشكلة أن ما يطرح في التطبيع الخليجي أمر لا يمكن لأي فلسطيني قبوله، لأنه بالأساس لا شيء يُطرح حتى يلام الفلسطينيون على رفضه.
أما محاولة خلق مظلومية خليجية تجاه الفلسطينيين فهو أمر مثير للسخرية، أكثر منه يحتاج للرد.
والأهم أن شعوب الخليج التي دعمت القضية الفلسطينية حتى قبل النكبة رغم أنف حكامها أحياناً، لم يستشرها أحد في التطبيع الخليجي، الذي هو عملية قسرية، يفرضها حكام هذه الدول مثلما يفرضون أشياء أخرى كثيرة، بعضها صحيح وبعضها خطأ.
وفي هذا الإطار، لدى سؤال الإماراتيين عن خطة السلام التي طرحتها إدارة ترامب في استطلاع أجري مؤخراً، اعتبرت نسبة 12% فقط أنها قد تترك أثراً إيجابياً على المنطقة- وهو ما يختلف بشكل ملحوظ عن الترحيب من قبل مسؤولي بلادهم بالمقترح الأمريكي. كما لم يبدِ الإماراتيون تفاؤلاً كبيراً حيال الحكومة الإسرائيلية الجديدة المنتخبة في فصل الربيع الفائت، حيث ذكرت نسبة 66% أن الانتخابات ستخلّف تداعيات سلبية على المنطقة.
أما بالنسبة للعلاقات مع الإسرائيليين أنفسهم، فلا يوافق نحو 80% من الإماراتيين على مقولة “إن من يرغب من الشعب في أن تربطه علاقات عمل أو روابط رياضية مع الإسرائيليين يجب أن يُسمح له بذلك”
وأظهر استطلاع المؤشر العربي، الذي أجراه ونشر نتائجه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، أن 88% من العرب يرفضون أن تعترف بلدانهم بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مقابل 6% يرون عكس ذلك.
وسجل تقرير حول المؤشر أن رفض الاعتراف بـ”إسرائيل” هو الأعلى في منطقة الخليج، حيث أشار نحو 90% من المستطلعة آراؤهم بقطر والكويت إلى رفض اعتراف بلديهما بإسرائيل. كما عبر 65% من المواطنين السعوديين عن رفضهم لذلك، في حين رفض 29% الإدلاء برأيهم في الموضوع.
أما عن محاولة تقديم الدعم الخليجي للفلسطينيين على أنه صفقة خاسرة، فلم تفوض الشعوب الخليجية مثلها مثل باقي الشعوب العربية أحداً لإصدار كشف حساب بموقفها من القضية الفلسطينية، أو تلقي ثمن لدعمها للفلسطينيين باعتبار أنها قضية كل العرب وقضية كل الأحرار حتى في الدول الغربية.
كما تعلم شعوب الخليج مثل الشعوب العربية الأخرى أن الفلسطينيين يدافعون بالأساس عن مقدسات كل العرب مسلمين ومسيحيين، كما يعلمون أن مساعدة الغرب على إنشاء إسرائيل لم يكن استهدافاً لفلسطين تحديداً إلا لقيمتها التاريخية والدينية، والأهم أنها واسطة العقد العربي، ما يجعل احتلالها شوكة في ظهر العرب جميعاً تمنع تقدمهم ووحدتهم.
ولكن الأمر المؤكد أنه إذ نزلنا إلى مستوى الحديث عن المقايضة وحجم الاستفادة والمكاسب والخسائر جراء القضية الفلسطينية، فإن أنظمة الخليج هي الأكثر استفادة من النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وحتى من أخطاء القادة الفلسطينيين.
ففي جانب الخسائر، لا توجد خسائر خليجية على الإطلاق من الدعم الخليجي للقضية الفلسطينية، الذي ظل في أغلبه دعماً مالياً وفيراً نسبياً.
ولكنه دعم ضئيل جداً بالنسبة لإمكانات الخليج، ولا يمثل سوى نسبة صغيرة من حجم ما ينفق خليجياً على المساعدات الخارجية، أو الأموال المخصصة للسياسة الخارجية.
أما الدعم الخليجي السياسي فكان دوماً محافظاً بشكل يضمن عدم إغضاب الغرب، ويتوارى خلف المواقف العربية الأقوى (التي اختفت حالياً)
وبينما حوربت الأنظمة العربية الأكثر حماساً وتأييداً للقضية الفلسطينية من الغرب وإسرائيل مراراً، مثلما حدث مع مصر الناصرية عام 1967، وتوريط العراق في الحروب، ومضايقة الجزائر وسوريا وليبيا، فإن أنظمة الخليج لم تعانِ أي مضايقات غربية أو إسرائيلية جراء موقفها من القضية الفلسطينية (التي كانت دوماً هادئة وأقل من مستوى أغلب الدول العربية الأخرى).
ومقابل بضعة مليارات من التبرعات التي قدمتها دول الخليج مشكورة لأشقائهم الفلسطينيين، فقد جنى قادة دول الخليج بضعة تريليونات من الدولارات بفضل القضية الفلسطينية، كما سيتم تفصيله لاحقاً.
علماً أن دول الخليج قدمت مساعدات للعديد من الدول والشعوب الإسلامية الأخرى في أزمات مختلفة، بشكل أكثر كثافة من الفلسطينيين، مثل لبنان مصر، والعراق خلال حربه مع إيران، وباكستان والمجاهدين الأفغان (لأنهم رأوا أن هذه المساعدات تحقق لهم أهدافاً سياسية، أهم من القضية الفلسطينية).
يمكن القول إن وجود بعض دول الخليج كبلدان مستقلة، كما يبدو واضحاً في الحالة الإماراتية هو نتيجة حركة التحرر العربي التي نشأت كرد فعل على نكبة فلسطين، وجاءت في إطار إحياء عربي كانت فلسطين قضيته المركزية، والنشطاء الفلسطينيون من أبرز مؤسسيه.
ففي 16 يناير/كانون الثاني 1968، أصدرت الحكومة البريطانية بياناً سياسياً أعلنت عن نيتها الانسحاب التام من الخليج العربي، في موعد أقصاه نهاية عام 1971.
كان هذا القرار نتيجة صعود حركة التحرر العربي والقومية العربية التي امتدت إلى الجزيرة العربية، خاصة جنوبها، ما دفع بريطانيا للتفكير في الانسحاب، مع إعطاء دول الخليج استقلالها (الكويت والسعودية كانتا مستقلتين) بطريقة تضمن بقاء حكامها الحاليين الموالين للغرب، والحيلولة دون تكرار الاضطرابات وصعود الحركات القومية واليسارية مثلما حدث في اليمن الجنوبي وظفارالعمانية.
وكان هذا بسبب خوف لندن والغرب من تأثير التطور الذي مرت به بعض الإمارات الخليجية، بسبب انتشار التعليم، وتدفق العناصر العربية الوافدة من العالم العربي للعمل في المنطقة، ما ساعد على قيام وعي سياسي يمكن أن يترتب عليه نتائج قد تمس الأوضاع السياسية، كما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في حقول النفط، خاصة أن الدعوة للقومية العربية كانت قد شقت طريقها إلى المنطقة.
وكما قلنا آنفاً، كان هذا التأثير واضحاً في المنطقة التي ستصبح الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك، والتي كانت منطقة ثانوية في الخليج مقارنة بالكويت التي ظهر النفط فيها مبكراً، وشهدت طفرة تعليمية، والبحرين التي كانت أكثر انفتاحاً، والسعودية التي أصبحت دولة قوية موحدة، رغم أنها كانت فقيرة وتعاني من عزلة حضارية.
وبفضل حركة التحرر العربية التي كان قوامها القضية الفلسطينية، بدأت تهب رياح التغيير العربية على الإمارات، فقد استقبل الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، عام 1964، وفداً من الجامعة العربية برئاسة عبدالخالق حسونة الأمين العام للجامعة، مرحباً بالبرنامج المعد لتطوير الشارقة وباقي الإمارات.
ومع تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي عام 1966، تطورت في عهده الإمارة بشكل متسارع، كذلك الإمارات الشمالية. وقد كان قائداً تواقاً للتطوير والتحديث بشكل أدهش البريطانيين، وقد اعترضته مشكلة نقص الخبرات، فعمل على توظيف خبراء عرب وبريطانيين للمساعدة في عمليات التطوير وتأسيس البنى التحتية في الإمارات المتصالحة.
للمعلمين الفلسطينيين دور بارز في النهضة الخليجية الحالية (بالإضافة إلى المعلمين من العديد من الدول العربية الأخرى، أبرزها مصر بطبيعة الحال).
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية السابقة الدكتورة موضي الحمود، إن الكويت لن تنسى الإسهام الفلسطيني في نهضتها التعليمية، مشيرة إلى توثيق البعثة التعليمية الأولى بالأسماء والصور، التي شملت الرواد الأوائل من المعلمين الفلسطينيين في حقل التعليم مع بدايات الكويت الحديثة.
وكان المعلمون الفلسطينيون قد أصبحوا من مظاهر النهضة التعليمية في المشرق العربي، بل والعالم العربي كله، بفضل جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ حيث حصل أطفال اللاجئين الفلسطينيين على ميزة تعليمية متميزة على نظرائهم في المناطق الريفية في الدول العربية، وهو ما انعكس على نسبة التحاق اللاجئين الفلسطينيين بمؤسسات التعليم العالي في العالم العربي بمنتصف الستينات.
وفي عام 1969، كانت نسبة الطلاب الفلسطينيين الذين يلتحقون بالتعليم العالي أقرب إلى نسبة الطلاب الأوروبيين وليس العرب؛ إذ كان هناك 11.4 طالب من بين كل 1000 فلسطيني، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لليونسكو.
وأوضح الكتاب السنوي أن هذه النسبة أكثر من نسبة الطلاب في بريطانيا في ذلك الوقت، والتي كانت تمثل 10.8 طالب، وفي اليونان 9.76 طالب، وألمانيا 8.3 طالب، أو مصر التي كان عدد الطلاب في مرحلة التعليم العالي بها 7.1 طالب، وسوريا 6.8 طالب.
وتلفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها عن دور الأونروا إلى أن هناك عاملاً آخر ساهم في تقوية دور المعلمين الفلسطينيين بالمنطقة، هو أن الأنظمة العربية؛ وخاصة مصر التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، سمحت للطلاب الفلسطينيين بالالتحاق بالجامعات مجاناً، مثل الطلاب الفلسطينيين.
وأدى ذلك إلى لعب الفلسطينيين دوراً مهما في تلبية الحاجة إلى قوة عاملة محترفة؛ في الأردن، ثم دول الخليج العربي، وخاصة الكويت والسعودية، التي تفتقر إلى الموارد البشرية لتطوير صناعتها النفطية المزدهرة، وتم توظيف أغلبهم معلمين، وآخرين محاسبين ومهندسين وإداريين وما إلى ذلك.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الفلسطينيين المُهاجرين لم يتمتعوا بالحقوق المدنية والاجتماعية، واقتصرت إقامتهم في دول الخليج على تاريخ انتهاء تصاريح عملهم، ولكنهم كانوا يعيشون بشكل مريح للغاية، ويرسلون مكسبهم بالكامل تقريباً لأسرهم.
في نهاية الستينات كان حوالي 60% من المدرسات اللاتي يعملن في النظام التعليمي السعودي فلسطينيات، وذلك بفضل جهود الأونروا، والتي أحدثت ثورة تعليمية بين اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة كانت غير مسبوقة في العالم العربي في ذلك الوقت، حسبما نقلت صحيفة المصري اليوم عن تقرير هآرتس.
ومع انتشار هجرة العمال إلى الخليج العربي، بدأت السيدات غير المتزوجات في العمل كمدرسات في السعودية، على الرغم من أنه كان يطلب منهن مرافق ذكر وكان في الغالب والدهن، وتم تعيينهم بعقود سنوية في مدارس للفتيات فقط في أنحاء المملكة، وخاصة في الأماكن النائية، وتحملن ظروف المعيشة القاسية في الوقت الذي كن ينقلن رواتبهن لعائلاتهن في مخيمات اللاجئين بعد اقتطاع نفقات المعيشة الرئيسية.
في الخمسينيات والستينات وحتى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، لم تكن دول الخليج بهذا الثراء الذي نعرفه الآن، نعم ظهر النفط في بعضها، ولكن أسعاره كانت متدنية، وكميات الإنتاج قليلة، وقد تكون الكويت هي الاستثناء، إذ كانت أول دولة خليجية تتمتع بما يمكن تسميته وفرة نفطية.
كانت عملية إنتاج النفط منذ ظهوره في صالح الشركات النفطية الغربية التي كانت تحصل على نسبة كبيرة من الريع.
وخلال الستينيات حدثت تطورات محدودة في اتجاه تقوية موقف الدول المنتجة أمام الشركات والدول الغربية، ولكن ظل تأثيرها محدوداً رغم ضغوط حركات التحرر وبعض الدول المنتجة للنفط لرفع الأسعار، أو زيادة حصة الحكومات من ريع النفط الذي كانت الشركات الأجنبية تأخذ حصة كبيرة منه.
إذ كانت أسعار النفط مستقرة طيلة السنوات التي سبقت عام 1973 عند مستوى قريب من 3.6 دولار، لأن أسعار النفط كانت بيد الشركات العالمية، وخاصة مجموعة من الشركات تعرف باسم الأخوات الـ7 (إكسون وموبيل وشيفرون وغلف وتكساكو وشل وبي بي)، وكانت هذه الشركات هي التي تضع الأسعار بالاتفاق فيما بينها، وكانت هي التي تحدد حجم العرض في السوق، ولهذا كان السوق مستقراً ومتوازناً في أغلب الأحيان.
وحدها حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، خلقت وضعاً لم يكن ليحلم به أي من الدول المنتجة للنفط.
حرب أكتوبر التي تعد أهم حلقات النزاع العربي الإسرائيلي الذي نشب من أجل فلسطين.
وعندما اندلعت حرب رمضان من قبل مصر وسوريا بمعاونة عدد من الدول العربية الأخرى، قرر المنتجون العرب الرئيسيون تقييد إنتاج النفط دعماً للدول العربية المحاربة.
وأعلن أعضاء منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (أوابك وهي غير أوبك) حظراً نفطياً، رداً على قرار الولايات المتحدة بإعادة تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح خلال الحرب، واستمر الحظر حتى مارس/آذار 1974.
سبق أن جرت محاولات لتنفيذ حظر نفطي بعد حرب 1967، ولكن لم تنجح، وكانت السعودية دائماً ترى ضرورة الفصل بين النفط والسياسة، ولكن حرب أكتوبر/تشرين الأول خلقت زخماً جديداً في هذا الملف.
سمح هذا الحظر النفطي للدول المشاركة به بأن يثبتوا لـ”الشارع العربي” أنهم يفعلون شيئاً من أجل القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، ولكن من حيث السوق الحقيقي لم يكن الحظر شاملاً، بقدر ما هو تقليل في الإمدادات والإنتاج.
ولم يكن “الحظر” سارياً بالكامل من قبل السعودية تجاه الولايات المتحدة، كما أفاد جيمس أكينز، الذي كان السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.
ولكن الاحتمال الطويل الأجل الذي خلقه الحظر لارتفاع أسعار النفط وتعطل الإمدادات والركود، أدى إلى ارتفاع الأسعار، وخلق شرخاً قوياً داخل الناتو، وسعت كل من الدول الأوروبية واليابان إلى الابتعاد عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما ربط منتجو النفط العرب بين نهاية الحصار والجهود الأمريكية الناجحة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وبدأت إدارة نيكسون مفاوضات موازية مع منتجي النفط العرب لإنهاء الحظر، ومع مصر وسوريا وإسرائيل لترتيب انسحاب إسرائيلي من سيناء ومرتفعات الجولان بعد توقف القتال، وكانت هذه السياسات سبباً رئيسياً في مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية برعاية أمريكية، والتي أدت لمعاهدة السلام بين الجانبين.
بشكل مستقل، أدى الوضع الذي خلقه الحظر النفطي إلى قرار أعضاء أوبك استخدام نفوذهم للتحكم بآلية تحديد الأسعار العالمية للنفط، ورفع أسعاره، خاصة بعد أن تراجعت قيمة الدولار، بعدما تخلت واشنطن عن ربطه بالذهب.
جاء هذا الإجراء بعد عدة سنوات من الانخفاض الحاد في الدخل بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع كبرى شركات النفط الغربية.
واستقرت الأسعار عند مستوى بين 12.5 دولار و14 دولاراً خلال الفترة ما بين 1974 و1978، وكان إنتاج أوبك حينها مستقراً عند 30 مليون برميل يومياً. ولكن بقاء الأسعار مرتفعة ساهم كذلك في زيادة الإنتاج من خارج أوبك خلال نفس الفترة ليرتفع من 25 مليون برميل يومياً إلى 31 مليون برميل يومياً.
كان معنى ذلك إن إيرادات دول الخليج تضاعفت عدة مرات بعد حرب العبور، بل الزيادة كانت أكبر، لأن استفادة دول الخليج كان لها ثلاث أوجه هي كالتالي.
– تضاعف أسعار النفط عدة مرات
– زيادة نسبتهم في أرباح النفط بشكل كبير الذي كانت تستولي عليه الشركات الغربية المنتجة وصولاً إلى تأميم هذه الشركات
– زيادة إنتاج وحصة دول الخليج من السوق النفطي العالمي على حساب الدول العربية المحسوبة على معسكر القومية العربية مثل الجزائر والعراق وليبيا، إذ كان الغرب يفضل التعامل مع دول الخليج بدلاً من هذه الدول الأكثر استقلالاً في قرارتها والأقرب للاتحاد السوفييتي.
كانت إحدى النتائج الطبيعية الهامة لأزمة النفط 1973-1974 التأميم الواسع ولكن التدريجي للنفط.
وقد تم تأميم النفط بعد الأزمة من قبل الدول التي كانت لديها وجهات نظر غير مؤيدة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية في المنطقة.
بينما ترددت السعودية أولاً، وبالتالي اختارت “المشاركة في الأسهم”، قبل أن تدخل في التأميم بشكل كامل.
وبدأت العملية تدريجياً في العراق (1972-1975) وليبيا (1971-1974) والكويت (1976) والمملكة العربية السعودية (1976) وفنزويلا (1976).
يمكن القول إنه بينما ناضلت الدول والتيارات المعارضة للغرب لزيادة حصة الدول المنتجة للنفط (وهي الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية مثل العراق وليبيا والجزائر)، وضغطت في اتجاه التأميم، كان الأكثر استفادةً من ذلك دول الخليج خاصةً السعودية، كما كانت الرياض الأكثر استفادةً من الحرب التي شنتها مصر وسوريا.
خرجت السعودية من هذه الأحداث عملاقاً نفطياً، ولكن لديها منافسون آخرون في المنطقة، أبرزهم إيران وبصورة أقل، العراق.
تضاعف نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً بالقيمة الحقيقية، بين عامي 1968 و1978، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السبعينيات.
ولكن من الناحية السياسية، تحولت السعودية من دولة مهمة بالشرق الأوسط إلى أهم دولة في كثير من الأحيان، وأصبح الغرب يخطب وُد دول الخليج، خاصةً السعودية.
فقد اعتُبرت “صدمة أسعار النفط” لعام 1973، إلى جانب انهيار سوق الأسهم 1973-1974، الحدثَ الأول منذ الكساد العظيم الذي كان له تأثير اقتصادي مستمر.
وفي بعض الأوقات، كانت هناك طوابير أمام محطات الوقود في الدول الغربية، وبطبيعة الحال كان العالقون في هذه الطوابير يلعنون دول أوبك والدول العربية، وكان درساً لا يُنسى للغرب.
غيرت صدمة أسعار النفط أيضاً طبيعة العلاقات الدولية.
وأصبحت منطقة الشرق الأوسط أكثر محورية في السياسة الدولية، ولكن اللاعبين الرئيسيين في المنطقة بدأوا يتغيرون.
تقول الغارديان عن ذلك: “كانت العلاقات البريطانية في الخارج أكثر تركيزاً على المخاطر التي تشكلها روسيا والصين كجزء من الحرب الباردة. وكان يُنظر إلى دول الشرق الأوسط حتى عام 1973 على أنها أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم، لكن المملكة المتحدة ودولاً أخرى في الغرب أعطت المنطقة مزيداً من الاهتمام بعد الحظر”.
وكان إحدى النتائج العرضية للصراع العربي الإسرئيلي زيادة أهمية دول الخليج بالنسبة للغرب، نظراً لأن أغلب الدول العربية تقربت للمعسكر الشرقي السوفيتي رداً على تأييد الغرب لإسرائيل مثل مصر والعراق وسوريا والجزار إضافة إلى ليبيا.