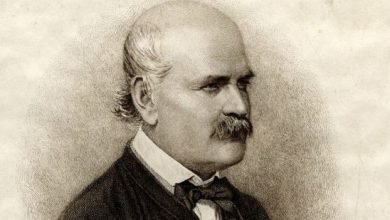لن يبقى إلى الأبد وأمثال ترامب لن ينقذوه.. كيف يمكننا تغيير النظام الرأسمالي الذي امتص جيوبنا؟

العديد من المجتمعات – أوروبا في ظل النظام القديم، الهند في فترة ما قبل الاستعمار أو الصين الإمبراطورية – عاشت في ظل نظام تفاوتي ذي طابع ثلاثي. السلطة تتقاسمها مجموعتان: طبقة المحاربين التي تسهر على ضمان احترام النظام وحفظ الأمن، وطبقة الكهنوت والمثقفين التي تسهر على توفير الإطار الروحي للمجتمع. وهما تتحكمان في طبقة عاملة تُوكل إليها مهمة تأمين الوظائف الإنتاجية للمجتمع: التغذية، الملابس… صعوبة هذه البنية تكمن في إيجاد توازن بين الطبقتين المسيطرتين، واللتين لكل واحدة منهما مشروعيتها، ويجب عليها في المقابل، أن تقبل بالحد من سلطتها. في الهند مثلاً، كان يتعين، في أحيان كثيرة، على الكاشتريا، أي طبقة المحاربين، منح مكانة بارزة للبرهمان، أي رجال الدين. يهدف هذا التركيب المعقد إلى توفير نموذج مقنع للاستقرار والتنمية من شأنه جعل سيطرتها تبقى مقبولة من قِبل طبقة العمال. في المجتمعات الأوروبية، تم الحرص على بناء انسجام اجتماعيّ، تراتبيّ وتفاوتيّ، بوجود الخطباء (oratores)، والمحاربين (bellatores) والعمال (laboratores). على المستوى العملي، يعج تاريخ هذه المجتمعات بالاستثناءات والصدامات.
انطلاقاً من عصر الحداثة، وخصوصاً مع الثورة الفرنسية، تم استبدال المجتمعات الثلاثية بما أدعوه بمجتمعات الملاك. الأيديولوجية والفكرة الرئيسية تختلف هنا: بدل الإقرار بأن الاستقرار ينبع من تكامل في الأدوار في ظل انسجام تراتبي، سيتم الإقرار بأن الحق في المِلْكِيَّة متاح للجميع وبأن الدولة المركزية تتكفل بحماية هذا الحق.
في القرن التاسع عشر، هذا التقديس للحق في الملكية أدى إلى تفاوت حادّ لصالح القلة القليلة. هذا علماً بأن التوسع الاستعماري والمنافسة بين الأمم الأوروبية قد ساهما في تشجيع هذه الظاهرة. هذه الديناميكية التفاوتية ستنتهي بالتسبب في تدمير ذاتي للمجتمعات الأوروبية ما بين سنتي 1914 و1945.
لكن الأيديولوجية التي أدعوها بـ “المَلّاكية”، والتي كانت خلف هذه الأزمات، ستُخْلِي مكانها لصالح حقبة جديدة تتميز بدعم المساواة، والتي ستمر عبر تنامي الضريبة التصاعدية، مع نسب 80٪ – 70٪ على المداخل والمواريث الأعلى ابتداء من سنوات العشرينيات، وانبثاق سياسات اشتراكية-ديمقراطية أكثر مساواة (مثلاً ما عُرف بـ “الصفقة الجديدة” مع روزفلت في الولايات المتحدة الأمريكية)، دون الحديث عن قدوم النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية. لكن التاريخ لم يتوقف هنا، حيث إن منعطفاً آخر سيحدث في سنوات الثمانينيات، مع تطبيق السياسة النيوملّاكية (النيوليبرالية) في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وأتباعهما من طرف العديد من الدول الأخرى.
لكن ماذا حدث في سنوات الثمانينيات حتى تنهار فجأة الحقبة الطويلة الأكثر مساواة في القرن العشرين؟
السردية المُقدمة من طرف رونالد ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية ومارغريت تاتشر في المملكة المتحدة تحتوي على جوانب معقولة. فهي تقول بأننا بالغنا في تطوير مفهوم الدولة الراعية، الأمر الذي أفضى إلى إضعاف المقاولين وقد حان الوقت من أجل تحجيم دور الدولة قصد إعادة تنشيط الاقتصاد. في ذلك الوقت، كانت فكرة لحاق ألمانيا واليابان المنهزمتين في الحرب العالمية الثانية بركب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تُرهب الحليفتين. لكن الحدث الذي أضفى حقاً المعقولية على الخطاب النيوليبرالي، هو سقوط النظام الشيوعي في نهاية سنوات الثمانينيات. حجم الفشل والمأساة الإنسانية السوفييتية كان فادحاً – 5٪ من السكان تعرضوا للسجن في سنوات الخمسينيات، في غالب الأحيان بسبب اختلاسات اقتصادية صغيرة. يتعلق الأمر بنسبة حبس أعلى خمس مرات من الولايات المتحدة الأمريكية الحالية وأعلى 50 مرة من الدول الأوروبية.
أنهت الكارثة السوفييتية، لزمن طويل، التفكير في إمكانية إنشاء مجتمع متساوٍ عن طريق تغذية الشعور باستحالة قيام اقتصاد ومجتمع عادلين.
ونلاحظ أن السردية الريغانية-التاتشرية، التي تدعي تنشيط النمو بفضل تصاعد الفوارق، لم تنجح. ارتفعت الفوارق خلال الفترة 1990- 2020، بالمقارنة مع الفترة 1950- 1980.
إن خطاب الاستحقاق المادي، أي أن الأغنياء عملوا بجهد حتى يصبحوا كذلك، لهو خطاب منافق في العمق. فهو يتيح للمستفيدين من النظام الاقتصادي، والاجتماعي والتعليمي، حشر الخاسرين في الزاوية نظراً لافتقادهم للجدارة، والاجتهاد، والموهبة، بعنف قلَّما نجده بالحدّة نفسها في الأنظمة السابقة. عندما نلقي نظرة موضوعية على وضعية الولوج إلى التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، نلاحظ أن المنحنى الذي يربط بين الدخل الأبوي واحتمالية الولوج إلى التعليم العالي ينتقل من 0٪ إلى 100٪، أو بشكل أدق من 20٪ إلى 95٪ عندما نمر من نسبة 10٪ الأكثر فقراً إلى نسبة 10٪ الأكثر غنى. في الحالة الفرنسية، يظل التفاوت في الولوج إلى التعليم العالي أقل سوءاً من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يبقى صارخاً.
في الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لاحظنا لأول مرة تصويت، ليس المتعلمين فقط، ولكن أيضاً أصحاب الدخول المرتفعة لصالح الحزب الديمقراطي. هذا يعني أن الأحزاب الاشتراكية-الديمقراطية لفترة ما بعد الحرب لم تعد قادرة على إقناع الطبقات الشعبية. هذه الأحزاب لم تنجح في تجديد أرضيتها الأيديولوجية قصد تكيفها مع التحديات الجديدة، خاصة التعليم والعولمة الاقتصادية. الأحزاب التي أدعوها بالاشتراكية-القومية تمزج بين رفض الهجرة والخطاب شبه الاجتماعي، كما هو الحال في فرنسا، حيث وصل الإحباط إلى أعلى درجاته في صفوف الأوساط الشعبية، مع حزب التجمع الوطني. نفس الحالة نجدها في إيطاليا، حيث تحالف حزب العصبة مع حركة خمسة نجوم، وحيث يحرص ماتيو سالفيني على الربط بين الحساسيتين العصبية والاجتماعية. يُوجد سيناريو كارثي يلوح في الأفق، وينذر بتفاقم مثل هذه التحالفات.
من أجل فهم هذا النوع من السيناريوهات التي يجب اجتنابها تماماً، يجب إلقاء نظرة على التاريخ، خاصة تاريخ الحزب الديمقراطي الأمريكي. فقد كان إبان القرن 19 عبارة عن حركة عنصرية مناصرة للاسترقاق والتمييز العنصري، كما عُرف بمواقفه الشاجبة لتصرفات النخب الصناعية والجمهورية في شمال الولايات المتحدة. فهو ينتقد نفاق النخب البرجوازية التي تعلن صداقتها للسود في العلن، في حين أنها لا تبحث، في الحقيقة، سوى على يد عاملة بسعر بخس. ومع ذلك، فالفضل يرجع، ما بين سنتي 1880 و1950، إلى الديمقراطيين في تطوير الحركة السياسية التي سيتمخض عنها تطبيق الضريبة على الدخل، والتأمينات الاجتماعية والصفقة الجديدة، كل هذا مع الإبقاء على مواقفهم العنصرية في الجنوب. فقد وجب الانتظار حتى سنوات الستينيات حتى يظهر أول مواقف الحزب الديمقراطي المدافعة عن الحقوق المدنية للأقليات. في نهاية المطاف، تخلى هذا الحزب الاشتراكي-القومي نهائياً عن مواقفه العنصرية متوجاً ذلك بانتخاب رئيس أسود. هذا التطور كان بطيئاً للغاية، مع كل ما خلفه من عنف غير مسبوق في الجنوب لعقود من الزمن. من الأفضل تجنب الفخ الهوياتي المماثل الذي تحاول الأحزاب القومية-الاشتراكية إيقاعنا داخله. إذا واصلنا إغلاق كل إمكانية أمام تقليص الفوارق الطبقية، أمام إعادة توزيع عادل للثروة بين مختلف فئات المجتمع بمعزل عن أصولهم، فسنجد أنفسنا أمام خطر أزمة سياسية ستتركز أكثر فأكثر حول القضايا الهوياتية والعنصرية.
هل الثورة هي الحل؟
فيما يخصني، أفضل صياغة برنامج نظام اشتراكي تشاركي واجتماعي-فيدرالي، يرتكز على التشاور الجماعي. بوسعنا الذهاب بعيداً في مسألة الإدارة المشتركة، من خلال تقاسم حق التصويت بين المساهمين والمستخدمين – الذي تمت تجربته في المقاولات الألمانية والسويدية. باستطاعتنا الذهاب نحو المِلْكية الاجتماعية والمؤقتة. يمكننا الذهاب بعيداً في تجارب الضريبة التصاعدية على الدخل، والميراث والمِلْكيَّة. من الممكن إرساء نظام ضريبة سنوية على المِلْكيَّة يكون رؤوفاً بالملكيات الأضعف، في حدود 0.1٪، وهو ما يشكل نسبة أقل من ما هو مُطبق حالياً في إطار الضريبة العقارية.
في المقابل، وبالنسبة للملكيات التي تصل إلى عدة مليارات من اليوروهات، أقترح بأن تكون الضريبة التصاعدية على الملكية أكثر أهمية: 50٪، 60٪، 90٪. السُّلَّم المُقترح سيضع حداً لحيازة الممتلكات المقدرة بعدة مليارات أو مئات الملايين. مع الإبقاء على إمكانية حيازة الممتلكات التي هي في حدود عشرات الملايين. يُمكن نعت هذا السلم بكافة النعوت إلا بأنه متشدد. أكبر عائق أمام تطبيق هذه الإجراءات ليس هو معارضة النخب التي ترفضه – رغم أنهم يلعبون دوراً مهماً – بقدر ما هو استقلال المجال الاقتصادي بذاته بشكل مفرط.
لماذا تخلى المؤرخون، الصحفيون، المواطنون عن الاقتصاد لصالح الاقتصاديين الذين يدَّعون لأنفسهم حق امتلاك خبرة ليست في ملكهم؟
الاقتصاد أمر يتعلق بالتاريخ، بالعلوم الاجتماعية. في إمكان، بل من واجب كل شخص، امتلاك فكرة حول هذه المواضيع والانتساب إلى هذه القضايا.
طريقة التطبيق
مدير الدراسات في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية وأستاذ في مدرسة باريس للاقتصاد. هو خريج المدرسة العليا للأساتذة و حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد. اشتهر بأعماله في مجال اللامساواة الاجتماعية و الاقتصادية، وفق منهج بحثي تاريخي مقارن.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]