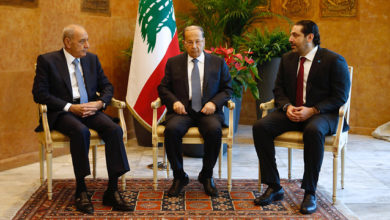طرد بعض الباحثين وضغط على آخرين لتغيير آرائهم.. ماذا يريد ترامب من علماء أمريكا؟

ترامب يحارب علماء أمريكا وتسبب في جعل مئات من خيرة العلماء الأمريكيين يبحثون عن وظائف».
ففي غضون ثلاث سنواتٍ فقط، قلَّصت إدارة ترامب دور العلم في صنع السياسة الفيدرالية الأمريكية، مع وقف أو تعطيل المشاريع البحثية في كافة أنحاء البلاد، ما مثّل تحوّلاً في الحكومة الفيدرالية يقول الخبراء إنّه قد يستمر لعقود.
إذ أوقف المُعيّنون سياسياً الدراسات الحكومية، وقلّلوا تأثير العلماء على القرارات التنظيمية، وضغطوا في بعض الحالات على الباحثين ليتوقّفوا عن الحديث علناً، حسبما ورد في تقرير لصحيفة New York Times الأمريكية.
وتحدّت الإدارة على وجه الخصوص الكشوفات العلمية المُتعلّقة بالبيئة والصحة العامة، والتي عارضتها صناعات مثل التنقيب عن النفط وتعدين الفحم. كما أعاقت الأبحاث حول تغيّر المناخ بسبب البشر، وهي الأبحاث التي رفضها الرئيس ترامب رغم الإجماع العلمي العالمي حولها.
لكن تآكل العلم يتجاوز مسائل البيئة والمناخ: ففي سان فرانسيسكو، تعطّلت دراسةٌ عن آثار الكيماويات على النساء الحبليات بعد أن انتهى التمويل الفيدرالي فجأة.
وفي واشنطن العاصمة، جرى حلّ لجنةٍ علمية كانت تُوفّر خبراتها في الوقاية من الحشرات الغازية. أما في كانساس سيتي، بولاية ميزوري، فقد أدّى النقل المُتسرّع لوكالتين زراعيتين تُموّلان علم المحاصيل ودراسة اقتصاديات الزراعة إلى رحيل الموظفين وتأخير مئات الملايين من الدولارات في الأبحاث.
وقال مايكل جيرارد، مدير مركز Sabin Center for Climate Change Law بجامعة كولومبيا، الذي تتبّع أكثر من 200 تقرير عن جهود إدارة ترامب لتقييد العلوم أو إساءة استخدامها: «إنّ تجاهل الخبرات في الحكومة الفيدرالية الآن بات أسوأ من أيّ وقتٍ مضى. الأمر منتشر».
إذ يرحل مئات العلماء، الذين يقول الكثير منهم إنّهم يشعرون بالفزع لرؤية أعمالهم تنفض.
ومن بين هؤلاء العلماء ماثيو ديفيس، الذي دعّم بحثه حول «المخاطر الصحية للزئبق على الأطفال» أول قوانين تقليل انبعاثات الزئبق من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ولكن في العام الماضي، بعد أن رُزِقَ بطفله الجديد، طُلِبَ منه أن يساعد في دعم إلغاء بعض تلك القوانين. وقال: «صرت الآن جزءاً من المدافعين عن هذا المستقبل الأكثر قتامةً وقذارة».
وفي العام الجاري، بعد عقدٍ كامل من العمل في «وكالة حماية البيئة» الأمريكية؛ غادر ديفيس.
وقال جويل كليمنت، كبير خبراء السياسات المناخية السابق بوزارة الداخلية، الذي استقال عام 2017 بعد أن أُعيد تعيينه في وظيفةٍ لجمع حقوق النفط والغاز الطبيعي: «اللوائح تذهب وتعود، ولكن تخفيف القدرات العلمية داخل الحكومة سيستغرق وقتاً طويلاً لاستعادته». وهو يعمل الآن في مجموعة Union of Concerned Scientists المعنية بمناصرة العلم والعلماء.
وقال ترامب باستمرار إنّ اللوائح الحكومية خنقت الشركات وأحبطت بعض الأهداف الرئيسية للإدارة، مثل زيادة إنتاج الوقود الأحفوري. وتضمّنت العديد من المواجهات الأكثر قسوة مع العلماء الفيدراليين بعض القضايا، مثل: الرقابة البيئية واستخراج الطاقة -وهي المناطق التي جادلت المجموعات الصناعية بأنّ الجهات التنظيمية تجاوزت داخلها في الماضي.
إذ قال بيانٌ من البيت الأبيض العام الماضي: «بدأت الشركات أخيراً في التحرُّر من سطوة واشنطن، وبدأ الاقتصاد الأمريكي في الازدهار نتيجةً لذلك». وحين سُئِلوا عن دور العلم في صنع السياسة، رفض مسؤولون من البيت الأبيض التعليق رسمياً.
وتعكس جهود الإدارة لوقف بعض المشاريع البحثية موقفاً محافظاً قديماً، ينص على أنّ بعض العمل العلمي يُمكن تأديته بطريقةٍ فعّالة من حيث التكلفة عن طريق تركه للقطاع الخاص، وعدم مطالبة دافعي الضرائب بسداد فاتورته.
إذ كتب اثنان من مُحلِّلي مؤسسة Heritage Foundation البحثية المُحافظة عام 2017، عن مقترحات الإدارة للقضاء على مختلف برامج تغيّر المناخ والطاقة النظيفة: «إنّ القضاء على النفقات المهدرة، التي لا علاقة لبعضها بدراسة العلم على الإطلاق، تُمثِّل إدارةً ذكية وليس هجوماً على العلم».
وأعربت المجموعات الصناعية عن دعمها لبعض تلك الخطوات، ومن بينها مقترح «وكالة حماية البيئة» المثير للجدل بفرض قيودٍ جديدة على استخدام الدراسات العلمية بحجة الشفافية. إذ أثنت شركة American Chemistry Council، مجموعة تجارة الكيماويات، على المقترح قائلةً: «إنّ هدف توفير المزيد من الشفافية في الحوكمة، واستخدام أفضل العلوم المُتاحة في العملية التنظيمية، يجب أن تكون من المُثُلِ التي نعتنقها جميعاً».
وفي بعض الحالات، أُحبِطَت جهود الإدارة لإلغاء العلوم الحكومية. وفي كل عام، يقترح ترامب خفضاً هائلاً لميزانيات مختلف الوكالات الفيدرالية، مثل: «المعاهد الصحية الوطنية» الأمريكية، ووزارة الطاقة، و «مؤسسة العلوم الوطنية». ولكن الكونغرس تكون له الكلمة الأخيرة دائماً في ما يتعلّق بمستويات الميزانية، وقد رفض المُشرّعون من الحزبين تلك التخفيضات.
فعلى سبيل المثال، قال السيناتور لامار ألكساندر (الجمهوري من تينيسي) مؤخراً، دعماً لتمويل المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة: «هذا يسمح لنا بالاستفادة من سلاح الولايات المتحدة السري، ألا وهو قدرتنا الاستثنائية على أداء البحوث الأساسية».
ونتيجةً لذلك، تواصل الكثير من البرامج العلمية الازدهار، ومن بينها استكشاف الفضاء في وكالة ناسا، والأبحاث الطبية في «المعاهد الصحية الوطنية». إذ ارتفعت الميزانية بنسبة أكثر من 12% منذ وصول ترامب إلى منصبه، ويُواصل الباحثون تقدُّمهم العلمي في مجالاتٍ مثل علم الأحياء الجزيئي وعلم الوراثة.
ومع ذلك، فقد نجحت الإدارة في التخلُّص من العلوم الفيدرالية في مجالات أخرى.
ففي «وكالة حماية البيئة» مثلاً، تراجعت أعداد الموظفين إلى أقل مستوياتها خلال العقد الماضي.
وقال أكثر من ثلثي المشاركين في مسحٍ، أُجرِيَ على العلماء الفيدراليين في 16 وكالة، إنّ تجميد عملية التوظيف ورحيل العلماء زادا من صعوبة إجراء العمل العلمي. وفي يونيو/حزيران، أمر البيت الأبيض الوكالات بخفض عدد المجالس الاستشارية الفيدرالية التي تُقدّم المشورة التقنية بنسبة الثلث.
وقال البيت الأبيض إنّه يهدف بذلك إلى القضاء على اللجان التي لم تعُد لها ضرورة. وركّز خفض المجالس حتى الآن على القضايا التي تشمل الأنواع الغازية، والابتكار في مجال الشبكات الكهربائية.
وفي وقتٍ تنسحب خلاله الولايات المتحدة من زعامة العالم في مجالات أخرى مثل حقوق الإنسان أو المعاهدات الدبلوماسية؛ حذّر الخبراء من أنّ التراجع في المجال العلمي لا يقل خطورة أيضاً.
إذ إنّ العديد من إنجازات القرن الماضي التي ساعدت في جعل الولايات المتحدة قوةً عالميةً مرهوبة الجانب، ومنها المكاسب في متوسط العمر المتوقّع وانخفاض تلوّث الهواء وزيادة الانتاجية الزراعية، جاءت نتيجة أنواع البحوث الحكومية التي تتعرّض للضغوط الآن.
وقالت ويندي إي فاغنر، أستاذة القانون بجامعة تكساس في أوستن، التي تدرس استخدام العلوم بواسطة صُنّاع السياسة: «حين نذبح قدرة الحكومة على استخدام العلم بطريقةٍ مهنية؛ يزيد ذلك خطورة أن نبدأ في اتّخاذ قرارات سيئة، أو أن تفوتنا المخاطر الجديدة على الصحة العامة».
وتحدث مناوشاتٌ حول استخدام العلم في صنع السياسة داخل كافة الإدارات، إذ تضغط الصناعات بشكلٍ روتيني في مواجهة الدراسات الصحية التي قد تُبرِّر تشديد قوانين التلوّث مثلاً. ويشكو العلماء عادةً من عدم كفاية الميزانيات لتأدية عملهم. لكن الكثير من الخبراء يقولون إنّ الجهود الحالية لتحدّي نتائج الأبحاث تتخطّى ما كان يحدث مسبقاً بكثير.
وفي مقالٍ نُشِرَ بدورية Science العلمية العام الماضي، كتبت ويندي أنّ بعض خطوات إدارة ترامب، مثل سياسة منع أكاديميين بعينهم من المشاركة في المجلس الاستشاري العلمي لوكالة حماية البيئة أو مقترح تحديد أنواع البحوث التي يُمكن للجهات التنظيمية البيئية الأخذ بها، «تُشير إلى خروجٍ حاد عن مسار الماضي».
وبدلاً من المعارك المنعزلة بين المسؤولين السياسيين والخبراء المهنيين؛ قالت إنّ تلك الخطوات هي محاولةٌ لتقييد كيفية استخدام الوكالات الفيدرالية للعلم في المقام الأول.
وأثارت بعض الاشتباكات مع العلماء رد فعلٍ عام عنيف، مثل ضغط مسؤولي ترامب على وكالة التنبؤ بحالة الطقس القومية، من أجل دعم تأكيد الرئيس الخاطئ هذا العام على أنّ إعصار دوريان هدّد ولاية ألاباما.
لكن الاشتباكات الأخرى لم تحظَ باهتمامٍ كبير رغم أهميتها.
فهذا العام مثلاً، تلقّى كبير علماء تغيُّر المناخ بإدارة المنتزهات الوطنية باتريك غونزاليس خطاب «وقفٍ عن العمل» من المشرفين، بعد أن أدلى بشهادته أمام الكونغرس بشأن المخاطر التي يفرضها الاحتباس الحراري على المنتزهات الوطنية.
وقال غونزاليس: «رأيت الأمر بمثابة محاولة تخويف. إنّه تدخّلٌ في العلم، ويُعيق عملنا»، مُضيفاً أنّه كان يتحدّث بصفته أستاذاً مساعداً ملحقاً بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو المنصب الآخر الذي يشغله.
رغم أنّ الكونغرس لم يوافق على مقترحات ترامب بخفض ميزانيات الوكالات العلمية، لكن الإدارة عثرت على طرقٍ أخرى لتحقيق أهدافها.
والاستراتيجية واحدة: القضاء على مشاريع البحث الفردية التي لا يحميها الكونغرس مباشرة.
فمثلاً، بعد شهرٍ واحد من انتخاب ترامب؛ حلّت وزارة التجارة لجنةً علمية تتألّف من 15 شخصاً مُكلّفين باستكشاف كيفية إعداد تقييمات المناخ الوطنية، وهي الدراسات التي فرضها الكونغرس من أجل تحديد مخاطر تغيّر المناخ وإفادة المسؤولين المحليين.
كما أغلقت الوزارة مكتب كبير الاقتصاديين، الذي كان يُجري أبحاثاً واسعة النطاق طوال عقود على مواضيع مثل الآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية.
وبالمثل، سحبت وزارة الداخلية تمويلها لتعاونيات حفظ المسطحات الطبيعية، وهي عبارةٌ عن 22 مركز أبحاثٍ إقليمياً يتناول قضايا مثل فقدان البيئات الطبيعية وإدارة الحرائق الهائلة. وفي حين استخدمت كاليفورنيا وألاسكا أموال الولاية لإبقاء مراكزها مفتوحة، ما يزال هناك 16 مركزاً في حالةٍ من التيه.
وقال مسؤولٌ بوزارة التجارة إنّ لجنة المناخ التي أوقفتها الوزارة لم تُنتِج تقريراً، وسلّط الضوء على الجهود الأخرى لتعزيز العلم، مثل الترقيات الكبيرة لنماذج الطقس في البلاد.
في حين قال مسؤولٌ بوزارة الداخلية إنّ قرارات الوكالة «مبنيةٌ فقط على الحقائق وتستند إلى القانون»، وإنّ الوكالة ستواصل السعي وراء الشراكات الأخرى من أجل التقدُّم بعلم حفظ الأحياء.
وتوقّف أيضاً بحثٌ كان من المحتمل أن يُمثِّل عقبةً في طريق وعد ترامب بتوسيع إنتاج الوقود الأُحفوري. وفي عام 2017، ألغى مسؤولو الداخلية دراسةً بقيمة مليون دولار أمريكي من جانب «الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب»، حول المخاطر الصحية لتعدين الفحم بـ»إزالة قمم الجبال» في مناطق مثل فرجينيا الغربية.
و»إزالة قمم الجبال» هو مصطلحٌ دراماتيكي بالدرجة نفسها على أرض الواقع -إذ يجري تفجير جانب التل بالمتفجرات، واستخراج الفحم من البقايا-، لكن الآثار الصحية لها لم تُفهَم بعد بالكامل. حيث يُمكن للعملية أن تُطلق غباراً فحمياً كثيفاً وتُرسِلَ المعادن الثقيلة إلى المجاري المائية، كما اقترحت عددٌ من الدراسات ارتباطها بالمشكلات الصحية مثل أمراض الكلى والعيوب الخلقية.
وقال جوزيف بيزارشيك، مُنظّم التعدين الذي أُوكِلَ في عهد أوباما بالدراسة المُنتهية الآن: «كانت الصناعة تضغط من أجل إلغاء تلك الدراسات. لم نكُن نعلم طبيعة الإجابة، لكنّنا كنا بحاجةٍ لأن نعرف: هل كانت الحكومة تُرخّص تعدين الفحم بطريقةٍ تُسمِّم الناس، أم لا؟».
ورغم تراجع تعدين الفحم في السنوات الأخيرة، أظهرت بيانات الأقمار الصناعية أنّ 155 كيلومتراً مربعاً على الأقل جرى تعدينها مؤخراً في منطقة أبالاشيا شرق الولايات المتحدة منذ عام 2016. وأضاف بيزارشيك: «ما تزال الدراسة مهمةً اليوم بقدر أهميتها قبل خمس سنوات».
يُمكن أن يرقى خفض تمويل الأبحاث إلى مستوى الانتكاسات البحثية الكبيرة.
إذ إنّه طوال سنوات، اشتركت «وكالة حماية البيئة» مع «المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية» في تمويل 13 مركزاً لصحة الطفل في مختلف أنحاء البلاد. وكانت تلك المراكز تُجري دراساتها حول آثار التلوّث على تطوّر الأطفال، إلى جانب أشياء أخرى. ولكن في العام الجاري، أنهت «وكالة حماية البيئة» تمويلها.
وداخل جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، كان أحد تلك المراكز يدرس كيف يُمكن أن تُؤثّر الكيماويات الصناعية -مثل مثبط اللهب في الأثاث- على نمو المشيمة والأجنة. لكن جوانب البحث الأساسية توقّفت الآن.
وقالت تريسي وودراف، التي تُدير المركز: «كلما زاد الوقت الذي يمضي دون تمويل؛ ازدادت صعوبة بدء هذا البحث من جديد».
وفي بيانٍ لوكالة حماية البيئة، أوضحت الوكالة أنّها تتوقّع فرصاً مُستقبلية لتمويل أبحاث صحة الطفل.
أما في وزارة الزراعة، فقد قال الوزير سوني بيردو في يونيو/حزيران إنّه سينقل وكالتي أبحاثٍ رئيسيتين من واشنطن إلى كانساس سيتي: «المعهد الوطني للأغذية والزراعة»، وهي وكالةٌ علمية تُموّل الأبحاث الجامعية في موضوعات مثل كيفية تربية الماشية وإنتاج ذرة تستطيع التكيّف مع ظروف الجفاف، و «دائرة البحوث الاقتصادية» التي يُنتِجُ اقتصاديوها دراسات لصُنّاع السياسة حول اتجاهات الزراعة السائدة والتجارة والريف الأمريكي.
وكان هناك قرابة 600 موظّف الذين تعيّن عليهم تحديد ما إذا كانوا يرغبون في الانتقال أم لا، خلال أربعة شهورٍ فقط. ولم تستطع غالبيتهم فعل ذلك، كما أنّ ثلثي من واجهوا قرار النقل تركوا وظائفهم.
وفي أغسطس/آب، بدا وكأنّ القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني كان يحتفل بالمغادرين.
إذ قال في تعليقٍ مُسجّلٍ بتقنية الفيديو، خلال حفل الحزب الجمهوري بكارولينا الجنوبية: «من شبه المستحيل إقالة موظفين فيدراليين. لكنّك حين تقول بكل بساطة: حسناً، سوف نُخرِجكُم من فقاعتكم، بعيداً عن طريق بيلتواي الدائري، وبعيداً عن جنة الليبرالية في واشنطن العاصمة، وننقلكم إلى جزءٍ حقيقيٍ من البلاد. حينها يستقيلون. فيالها من طريقةٍ رائعة لتنظيم الحكومة وفعل ما كُنّا نعجز عنه منذ فترةٍ طويلة».
ورفض البيت الأبيض التعليق على خطاب مولفيني.
وقد أدّت تلك الاستقالات إلى حالةٍ من الهياج.
إذ تأخّرت أو تعطّلت عشرات الدراسات المُخطّط لها في مواضيع مثل تدعيم صناعة الألبان، واستخدام المبيدات، داخل «دائرة البحوث الاقتصادية». وقالت لاورا دودسون، الاقتصادية والقائمة بأعمال نائب رئيس النقابة التي تُمثّل موظفي الوكالة: «يُمكنّك تسمية أيّ موضوعٍ يتعلّق بالزراعة، وستجد أنّنا خسرنا خبيراً فيه».
ويُدير «المعهد الوطني للأغذية والزراعة» منحاً بقيمة 1.7 مليار دولار لتمويل الأبحاث، في قضايا مثل الأمن الغذائي والتقنيات الغذائية، التي تُساعد المزارعين على تحسين إنتاجيتهم. وقال الموظفون إنّ فقدان العاملين أخّر مئات الملايين من الدولارات المُخصّصة لتمويل الأبحاث المُخطّط لها حول الآفات والأمراض التي تُصيب العنب، والبطاطا الحلوة، وأشجار الفاكهة.
وقال الموظفون السابقون إنّهم ما يزالون مُتشكّكين في أنّ الوكالات يُمكن إصلاحها سريعاً. إذ أوضح سوني راماسوامي، مدير «المعهد الوطني للأغذية والزراعة» حتى عام 2018: «ستستغرق إعادة بناء الوكالات فترةً تتراوح بين خمس وعشر سنوات».
وقال بيردو إنّ تلك الخطوات من شأنها أن تُوفّر المال، وتُقرّب المكاتب من المزارعين. وأوضح في بيانه: «لم نُنفّذ عمليات النقل تلك باستخفاف». وأضاف مسؤولٌ بوزارة الزراعة أنّ كلا الوكالتين كانتا تضغطان لمواصلة عملهما، لكنّه أقرّ بأنّ بعض المنح قد تتأخّر لشهور.
علاوةً على وقف بعض البرامج، كانت هناك حالاتٌ بارزة تحدّت خلالها الإدارة الأبحاث العلمية الراسخة. فمنذ وقتٍ مُبكّر، وبالتزامن مع إلغاء اللوائح المُتعلّقة بالصناعة؛ بدأ مسؤولو الإدارة التشكيك في نتائج الأبحاث التي تقوم عليها تلك اللوائح.
وفي عام 2017، طلب مساعدو مُدير «وكالة حماية البيئة» آنذاك سكوت برويت من اقتصاديي الوكالة أن يُعيدوا إجراء تحليلٍ عن وسائل حماية الأراضي الرطبة، بعد أن استُخدِم للدفاع عن قانون المياه النظيفة من عهد أوباما. وبدلاً من استنتاج أنّ وسائل الحماية ستوفّر 500 مليون دولار من المكاسب الاقتصادية، فقد طُلِبَ منهم إدراج تلك المكاسب على أنّها مستحيلة القياس، بحسب إليزابيث ساوذرلاند التي استقالت عام 2017 بعد 30 عاماً من الخدمة في «وكالة حماية البيئة» -لتُنهي خدمته بصفتها مسؤولةً بارزة في مكتب المياه.
وقالت إليزابيث: «ليس من الغريب أن تأتي إدارةٌ جديدة وتُحاول تغيير اتّجاه السياسة. ولكنّك ستبحث بحكم العادة عن دراسات جديدة لتُعيد تحليلك بعناية. ولكنّهم كانوا يبعثون بدلاً من ذلك برسالةٍ فحواها أنّ كافة الاقتصاديين والعلماء والمهنيين في الوكالة لا أهمية لهم».
وأظهرت الوثائق الداخلية أنّ المسؤولين السياسيين في «وكالة حماية البيئة» تجاهلوا خبراء الوكالة المهنيين في أكثر من مناسبة: بما في ذلك خطوة تخفيف تنظيمات الحرير الصخري (الإسبوستس)، وقرار عدم حظر مبيد كلوربيريفوس الحشري، والحكم بأنّ أجزاءً من ولاية ويسكونسن كانت مُمتثلةً لمعايير الضباب الدخاني. كما استبعدت وزارة الداخلية تحليلاتها القانونية والبيئية الخاصة في ما يتعلّق بتقديم مقترحات رفع مستوى سد شاستا في كاليفورنيا.
وشكّك مايكل عبود، المتحدث باسم «وكالة حماية البيئة»، في رواية إليزابيث خلال ردٍّ بالبريد الإلكتروني قائلاً: «هذا غير حقيقي».
وتضع «وكالة حماية البيئة» الآن اللمسات الأخيرة على نسخةٍ أضيق من قانون المياه التي ترجع إلى عصر أوباما، والتي أثارت بصيغتها المبكرة غضب آلاف المزارعين ومُربّي الماشية بطول البلاد، إذ رأوا أنّها مُقيِّدةٌ للغاية.
وقال عبود، موضحاً أنّ العديد من القوانين التي أقرّتها إدارة أوباما عُلِّقت في المحكمة وصارت بحاجةٍ إلى المراجعة: «عملت وكالة حماية البيئة في عهد ترامب على وضع أقوى اللوائح لحماية الصحة البشرية والبيئة. وبموجب القانون، فإنّ وكالة حماية تستخدم -وستواصل استخدام- أفضل العلوم المتاحة أثناء وضع القوانين، بغض النظر عن مزاعم قلةٍ من الموظفين الفيدراليين».
وأشار العلماء وخبراء الصحة إلى خطوتين وجدوا أنّهما مُثيرتان للقلق على وجه الخصوص. فمنذ عام 2017، بدأت «وكالة حماية البيئة» في منع أكاديميين بعينهم من الانضمام إلى المجلس الاستشاري العلمي الذي يُقدّم تدقيقاً في علوم الوكالة، وزادت بدلاً من ذلك عدد الأعضاء المُعيّنين المرتبطين بالصناعة.
قالت بيتسي سميث، عالمة المناخ التي تمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في «وكالة حماية البيئة»، والتي شهدت إلغاء دراستها الطولية حول آثار تغيّر المناخ على الموانئ الكبرى عام 2017: «في الماضي، حين كانت تترأسنا إدارةٌ غير مهتمةٍ بالبيئة للغاية، كُنا نبتعد عن الأضواء ونواصل عملنا. ولكنّنا نشعر الآن وكأنّ صناعة الوقود الأُحفوري هي من تُدير وكالة حماية البيئة. ويبدو وكأنّنا نتعرّض لهجومٍ بالجملة».
واستقالت بيتسي من منصبها بعد إلغاء المشروع.
وقال روبرت جي كافلوك، عالم السموم الذي تقاعد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 بعد العمل لصالح «وكالة حماية البيئة» طوال 40 عاماً، الذي شغل في آخر أيامه منصب القائم بأعمال مساعد مدير مكتب الأبحاث والتطوير بالوكالة: «يُمكن لفقدان العلماء المُخضرمين أن يمحوا سنوات أو عقود من الذاكرة المؤسسية».
إذ فقد مكتبه السابق، الذي يبحث في مواضيع مثل تلوّث الهواء والاختبارات الكيميائية، 250 عالماً وفرداً من الفريق التقني منذ انتخاب ترامب رئيساً، مع توظيف 124 فقط. أما من احتفظوا بوظيفتهم، داخل المكتب الذي يضم قرابة الـ1,500 شخص؛ فهم يواصلون عملهم بحسب كافلوك. ولكنّهم لا يبذلون جهداً كبيراً من أجل الترويج لنتائجهم المتعلقة بمواضيع مثيرة للجدل مثل تغيّر المناخ.
وأوضح كافلوك: «تستطيع أن ترى بسهولةٍ أنّهم لا يرغبون في تحريك المياه الراكدة».
ولا يُمكن قول المثل عن باتريك غونزاليس، كبير علماء تغيُّر المناخ بإدارة المنتزهات الوطنية، الذي تضمّن عمله مساعدة المنتزهات الوطنية على حماية نفسها من أضرار ارتفاع درجات الحرارة.
ففي فبراير/شباط، شهد غونزاليس أمام الكونغرس حول مخاطر الاحتباس الحراري، قائلاً إنّه كان يتحدث بصفته أستاذاً مساعداً ملحقاً بجامعة كاليفورنيا في بيركلي. كما يستغل انتسابه إلى بيركلي للمشاركة في كتابة تقريرٍ مُنتظر من جانب «الهيئة الحكومية الدولية لتغيّر المناخ»، وهي هيئة الأمم المتحدة التي تبني مفاهيم علم المناخ لقادة العالم.
ولكن في مارس/آذار، بعد فترةٍ وجيزة من شهادته، تلقّى غونزاليس خطاب «وقفٍ عن العمل» من مشرفه، الذي حذّره من أنّ انتسابه إلى بيركلي ليس منفصلاً عن عمله الحكومي -وأن تصرفاته انتهكت سياسة الوكالة. وقال غونزاليس إنّه رأى في الخطاب محاولةً لردعه عن الحديث علناً.
وحين طُلِبَ من وزارة الداخلية التعليق، قالت الوزارة إنّ الخطاب لم يُشِر إلى محاولةٍ لعقاب غونزاليس، وإنّ له حرية الحديث بصفته مواطناً له حقوقه.
وواصل غونزاليس، بدعمٍ من بيركلي، التحذير بشأن مخاطر تغيّر المناخ. إلى جانب عمله مع هيئة تغيّر المناخ التابعة للأمم المتحدة في وقت فراغه. كما تحدّث مرةً ثانية أمام الكونغرس في يونيو/حزيران. وقال: «أرغب في تقديم مثالٍ إيجابي للعلماء الآخرين».
ورغم ذلك، أوضح أنّ الجميع لا يملكون نفس رفاهية الحديث العلني بهذه الدرجة. وتساءل: «كم عدد العلماء الآخرين الذين يتحدثون علناً؟».